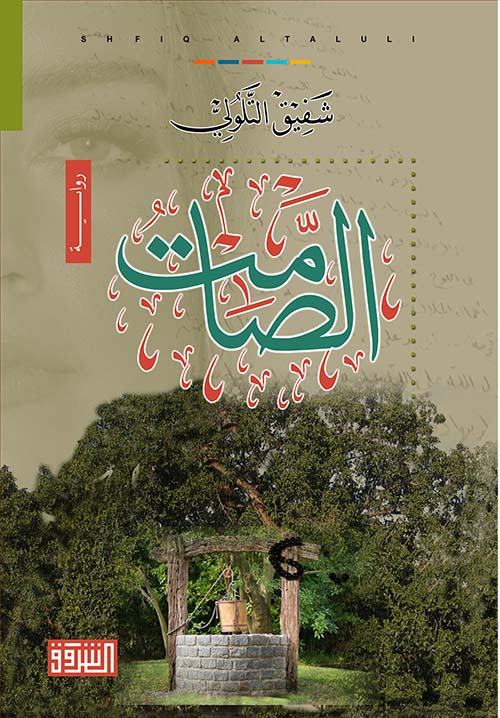رواية “الصّامت”لشفيق التلولي في اليوم السابع
تاريخ النشر: 13/05/22 | 7:21
القدس:12-5-2022 من ديمة جمعة السمان- ناقشت ندوة اليوم السّابع الثّقافية الأسبوعية المقدسيّة رواية “الصّامت” للأديب شفيق التّلولي، صدرت الرواية عام 2021 عن دار الشّروق في عمّان ورام الله، وتقع في 176 صفحة من الحجم المتوسّط.
افتتحت الأمسية مديرة الندوة ديمة جمعة السّمان فقالت:
رواية ” الصامت” فنتازيا جمعت بين الواقع والخيال عبر قرنين من الزمان
اصطحبنا الرّوائي الغزّيّ شفيق التّلولي في رحلة مزجت بين الواقع والخيال، جمعت بين الماضي والحاضر، في قالب أشبه ما يكون ب ” الأسطورة” فأدخلنا في دائرة الشّك والتّيه، فهل ما نقرأ حقيقة أم خيال؟
رواية “الصامت” جعلتنا نعيش مع كل شخصيّة من شخوص الرّواية ونقتنع بوجودها.
فليس من السّهل على الكاتب أن يجمع بين زمانين، يتنقّل بينهما من خلال الشّخوص التي رسمها، ليمرّر رسائل ناعمة، لم تكن مقحمة، جاءت سلسة، عبر حكايا الجدّات والأجداد، فكانت هناك الحقيقة، وكانت الخرافة، وكانت الأصالة. فربط بينها من خلال أسلوب الاسترجاع على لسان الراوي أمين، الذي عاد بذاكرته لحكايا الأجداد والجدات، فحملنا على جناح الخيال وحلّق بنا عاليا لنحط على سحب الخرافات، فجعلنا نسعد تارة، ونتوه تارة أخرى، فماذا يريد أن يقول الكاتب؟
الرواية تتحدث عن تاريخ فلسطين منذ العهد العثماني، مرورا بالانتداب البريطاني إلى زمن الاحتلال الإسرائيلي الذي نعيشه، ليبين أسباب الصراع الذي جعل من الشعب الفلسطيني ضحيّة للمؤامرات التي تكالبت عليه، فدفع ثمنها غاليا من الظلم والتهجير والتشريد عبر القرنين الماضيين.. ولا زال.
الكاتب يوثق التاريخ من زاوية مختلفة، بأسلوب غير تقليديّ.
فما سرّ المخطوطة التي ارتكزت عليها حبكة الرواية، وسهّلت على الراوي الدمج بين الماضي والحاضر بأسلوب أشبه ما يكون ب ” الأسطورة”؟ لماذا اهتمت الباحثة داليا بالمخطوطة؟ وما دلالات وجود مخطوطة تتحدث عن سيرة عائلة يعود نسبها لأحد الأولياء الصالحين ” الصامت”.
أراد الكاتب أن يرسّخ فكرة التمسك بالجذور، فمن ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. ولم يختر الكاتب أسماء شخوصة عبثا، إذ أجاد الاختيار، فكان هناك دلالة واضحة لكل اسم وفق الحقبة التّاريخية التي عاشها.
إذ كان لاسم الجد الأكبر الصامت – الوليّ الصالح- دلالات، وكان لاسم ابنه الجد ” بركات” دلالات، وكان لاسم الجد -الحفيد للصامت- “المنسيّ دلالات. دمج كل شخصية منها مع شخصيات تاريخية حقيقية، ليعلمنا الكاتب عن الحقبة الزمنية التى يتحدث عنها، لتظهر حقيقة الواقع الفلسطيني في كل فترة من الفترات الزمنية التي تناولها.
ولا زال للجد الأكبر “الصامت” تأثير على أحفاده، فهو الضمير الذي يزورهم في المنام، ويرشدهم إلى طريق الخلاص. فهو لم يمت بعد، لا زال حيّا في نفوسهم.
عكس الكاتب الواقع الفلسطيني المرير عبر أسماء شخوصه، دون حاجة منه ليتحدّث عنها أو الخوض فيها بشكل مباشر. فقد اعتمد الرّمزيّة عبر صفحات روايته، لتكون أقوى، وأكثر عمقا.
الرواية كُتبت بلغة جميلة، وتسلسل يتماشى مع أسلوب الاسترجاع الذي خدم الهدف من الرواية. إلا أنه جاء على حساب عنصر التشويق.
الرواية بمعلوماتها الغنيّة التي تتحدث عن تاريخ فلسطين عبر العصور، والتي تدل على ثقافة الكاتب الواسعة والمتنوعة وطنيا وسياسيا وشعبيا واجتماعيا تعتبر إضافة للمكتبة العربية.
وقال د.عاطف أبو سيف:
الصامت رواية الماضي الذي يسكن الحاضر، الأسطورة التي لا يكتمل الواقع دونها، والبحث الذي لا ينتهي مهما اكتشفنا من حقائق.
في روايته هذه يذهب الكاتب شفيق التلولي ليبحث في حكاية المخيم المختلفة بعد أن نبش الكثير من حكاياته في كتاباته السابقة.
هذه المرة يأخذنا معه ليعود في الحكاية بعيدًا من خلال البحث عن مخطوط مفقود حول أصل عائلة بطله الذي هو كاتب أيضا.
في رحلة البحث عن مخطوطة “الصامت” نجد أنفسنا نبحر في الماضي، نقرأ بعين مختلفة ما جرى للبلاد وللعباد منذ حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام، مرورا باحتلال فلسطين على يد البريطانيين، والمقاومة الفلسطينية للهجرة اليهودية، ومن ثم سرقة البلاد خلال النكبة وما تلا ذلك.
في الرواية تختلط الأسطورة بالواقع، فبقدر يقيننا أن الصامت أو المنسي هما مجرد شخصيات روائية ابتدعها الكاتب؛ ليحكي حكايته بقدر وقوعنا في وهم التصديق أنهما وجدا في لحظة زمنية نعرفها، فالمنسي قاتل إلى جوار عبد القادر الحسيني في القسطل، وإلى جانب عبد الناصر في معاركه في فلسطين، كما ثار قبل ذلك مع القسام والحاج أمين الحسيني.
يصعب أن تصدق مثل الكاتب أن المنسي غير موجود، ومثله يصيبك الشغف والقلق وانت ترى “أمين” ودالية يركبان القطار والسيارة والجمل من أجل أن يجدا ما يدلهما على حقيقة المخطوطة المفقودة.
إنها المخطوطة التي تشبه حياة المنسي وحياة الصامت بحاجة إلى من يكتشف وجودها.
رواية تمزج بين الواقع والفنتازيا، بين الماضي والحاضر، بين ما يمكن والمستحيل، بين الحقيقي والمتخيل، تمسكنا من يدنا في طريق تتدفق على جانبيه المشاهد من عصور مختلفة، تحملنا على التصديق أننا سنجد الحكاية الحقيقية، إنها الحكاية التي يجب أن يفعلها البطل حين تتحقق النبوءة، فيحمل رفات جدّه المنسي ويعيده إلى البئر.
وقتها تزول اللعنة، إنها اللعنة التي جعلتنا كلنا لاجئين، وجعل هذه الحكاية ممكنة، ونريد أن نصدقها ونجد المخطوطة.
وقالت د. روز اليوسف شعبان:
رواية تجمع بين دفتيها عدّة روايات، فهي رواية الشعب الفلسطينيّ ونضاله، ورواية الكاتب الذي شرع في كتابتها عن حبّ جمع بين أسير وحبيبة، فيتزوجها من خلف القضبان، ويأتي بنطفة من صلبه، يهرّبها من بين ثقوب الشباك خلال زيارتها له، لتنجب حياة أخرى دون أن يلتقيا على أمل البقاء في أرض أصبحت تنهشها وحوش آدميّة مستأذبة (ص 22). لكنّ الكاتب لم ينجح في كتابة روايته هذه التي أرادها، فموضوع المخطوطة التي تخصّ عائلته وجدّه الأولّ الصامت، شغلته عن كتابة الرواية.
والصامت هو وليّ من أولياء الله الصّالحين، كان يعيش في الشرقيّة في مصر، أمّا ابنه بركات فقد قدم مع ابراهيم باشا في حملاته على سوريا، واستقرّ في غزّة وتزوّج وأنجب ابنه بركات، الذي بدوره أنجب ولده المنسيّ الذي ستتبارك به بلدته. وكان الصامت قد أعطى ابنه بركات مخطوطة توضّح نسب العائلة وسرّها، وأوصاه بإخفائها في شجرة جمّيز حملها معه من مصر، وزرعها في وطنه الجديد في غزّة، ليستلمها المنسيّ من بعده.
أمّا الراوي فقد شغلته هذه المخطوطة التي سمع قصّتها من جدّته التي كثيرًا ما كانت تقصّ عليه قصصا خياليّة، ويصادف أنّ باحثة جامعيّة من مصر، ترسل للراوي رسالة تكتب له فيها أنّها تقوم ببحث جامعيّ؛ لتحليل مخطوطة الصامت التي أخذتْها من مقامه، وأنّها عرفت أنّ أهله في غزّة يمتلكون النصف الآخر من المخطوطة، ولعل الراوي يساعدها في تحليلها واكتشاف سرّها.
وتبدأ رحلة البحث وقدوم الباحثة دالية إلى غزّة، ثمّ سفرهما معا إلى مصر للبحث عن ضريح الصامت، الذي غدا مزارًا للدراويش للتبرّك به، لعلّ الجزء الثاني من المخطوطة موجود فيه. وعند الضريح يلتقي الراوي بزوجة المنسيّ التي كانت تقرأ الطالع من خلال لعبة ” الكوتشينة أو الشدّة)، وحين رأته صاحت:” رجع الصامت، رجع المنسيّ يا أولاد، أنت سليل الصامت حفيد المنسيّ، عرفت أنّك من أشار إليه المنسيّ يوم أن انسلّت روحه، وصعدت للسماء، وقتئذ، شخصت عيناه مخاطبًا ابني بصوت متقطّع، أنا المنسيّ من فلسطين، إن مرّ بي الفاتحون من بني قومي، فليلملوا رفاتي وليلقوه في تلك البئر، عندها تتبدد اللعنة التي حلّت بقومي، تشرق الشمس وتنجلي حروف مخطوطة الصامت”.(ص 173).
ثمّ يكتشف الراوي ودالية أنّ هناك فرقًا بين مخوطة المنسيّ التي كانت بحوزة الراوي، ومخطوطة الصامت التي كانت بحوزة دالية . عندها يتذكّر ما قالته جدّته أنّ المنسيّ اعتقل وربّما احتفظ الإنجليز والصهاينة بالمخطوطة وزوّروها.
عندما ذهب الراوي الى مقام المنسيّ تساءل:” كيف لي نقل رفات جدّي ونثره في تلك البئر؟ قبضتُ حفنة تراب من جوار الضريح، وقرّرتُ العودة بها إلى البئر العتيقة”.(ص 176)
ماذا أراد الكاتب شفيق التلولي أن يوصل للقراء من خلال هذه الرواية؟
لماذا اختار أن يدمج بين قصص الدروشة والأولياء الصالحين مع قضية الشعب الفلسطيني، ومعاناة سكان غزّة ونضال الشعب الفلسطيني؟
لماذا الصامت؟ هل ليشير إلى صمت الشعوب العربية إزاء ما يحدث للشعب الفلسطيني، وإزاء حقّه في تقرير المصير؟
وهل تزوير المخطوطة يشير إلى تزوير وتزييف التاريخ وإنكار حقّ الشعب الفلسطينيّ في أرضه ووطنه؟
لقد كتب الراوي أنّه كان يكتب رواية عن سجين وتهريب نطفة من صلبه من خلف القضبان، لكنّه لم يكمل هذه الرواية وليته فعل! فهذا موضوع في غاية الأهميّة وله أبعاده الفكريّة والوطنيّة والإنسانيّة. لقد وجدت أنّ رواية الصامت بعيدةً كلّ البعد عن مفاهيم ومعتقدات الناس في هذه الأيّام، خاصّة كلّ ما يتعلّق بالمخطوطات والدروشة والأولياء الصالحين والرموز المخفيّة في مقامات الأولياء، وما إلى ذلك. ويمكن حسب رأيي طرح قضيّة الشعب الفلسطينيّ الذي يعتبر جزءًا لا يتجزّأ من الأمّة العربيّة، كما أشار إلى ذلك الكاتب، بأسلوب يعتمد فيه التحليل المنطقيّ والواقعيّ.
فهل حقّق الكاتب شفيق التلولي مبتغاه من هذه الرواية وتمكّن من إيصال رسالته للقرّاء؟
وقالت هدى عثمان أبو غوش:
بقلمه الهادىء وبضمير المتكلّم، يسبر الكاتب مخاض وأوجاع وطنه الممتد من زمن حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام، وصولا إلى النكبة وما بعدها، من خلال السارد الكاتب أمين الذي يتولى بمهمة البحث عن سرّ المخطوطة، مخطوطة كي تعيد لمّ شمل العائلة، وقد اختار الكاتب شفيق التلولي كسر الروتين في تقنية السّرد من خلال غياب الشخصيات المتصارعة في الرواية، أو العاطفة التي تربط القارىء بالشخصيات تجاه شخصية معينة أو مكان ما، ممّا يخلق حالة تباعد بين القارىء وجسد الرواية، فالقارىء يستمع لحكايا الجدة ناعسة من خلال ما ينقله حفيدها السارد أمين، فعلى سبيل المثال، لم أتفاعل مع أحداث النكبة في غزة، التي من المفترض أن تحرّك مشاعرنا كقرّاء، بالرّغم من لغة الكاتب الجميلة، فقد ظهرت الشخصيات خلال ذاكرة الأجداد وحكاياهم دون أن تعبر الشخصيات حول مشاعرهم بأنفسهم أو الإسهاب حولهم، كقارئة كنت آمل أن أصل لحالة فيها غضب على المحتل، أو الدولة العثمانية، وأتعاطف مع الضحايا، ومن ناحية أُخرى استطاع الكاتب أن يشدنا حتى النهاية من أجل اكتشاف سرّ المخطوطة والمنسي.
دمج الكاتب التلولي في روايته بين مثلث الواقع والخيال الجامح والخرافة، وكان التنقل بين الماضي حيث النكبة والفترة العثمانية، وبين الحاضر في غزة وأحداث مصر، والتنقل بين الغناء التراثي والتصوف، الدراويش، الروح الصوفية، وتعدّد المكان، وفي ذلك التنقل بين الزمان والمكان المختلف، يجد القارىء نفسه يتساءل لماذا تهرب الرواية منّي؟ فيضطر لمحاولة استرجاع ما قرأه سابقا ومراجعة ما قرأه فيما بعد بسبب تسارع حركتها، والغموض الذي يكمنها.
استخدم الكاتب الأسلوب الرمزي بشكل ملحوظ، البئر وشجرة الجميز، الصامت، المنسي ،المخطوطة، وبذلك فإن الكاتب يحاول أن يستفز القارىء من أجل التفكير والتأمل كثيرا في معاني الرّواية، يثير فيه التساؤلات والتحليل في مفهوم الرمزية، وبدوري قمت بتحليل وفكّ بعض الرموز حسب وجهة نظري.
المنسي الذي تكرر كثيرا في الرّواية، والذي لا يعرف مكانه بالتحديد، فقد تعدّدت الأقاويل حول مكانه، هو رمز للاجىء الفلسطيني المنسي المقاوم الذي ما زال ينتظر حق العودة، هو الحي الغائب بعيدا عن بلاده، المنسي في البئر الظالم ينتظر الخلاص، هو الفلسطيني في كل مكان الذي ينتظر حق تقرير مصيره الذي طال كثيرا.
سمي المنسي،ربما لنسيان العالم قضية النكبة وفلسطين أو تجاهلهم إياها، أرى هنا في تسمية المنسي صرخة الكاتب لماذا نسيتم وطني؟
الصامت-هو نفسه اللاجىء، وهو يذكرني بحنظلة ناجي العلي الصامت الذي ينتظر الخلاص.
المخطوطة-البحث عن المخطوطة في الرواية من أجل لمّ شمل العائلة ونسبها، أي عودة اللاجىء لدياره ما هو إلا البحث عن الخلاص وحق العودة.
البئر-رمز للظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، من الهجرة والنكبة والنكسة، وكما يقول الكاتب في سياق الرواية،”منسيون كالحجارة في بئر عتيقة”، فمن سينقذ المنسي من بئره العميق؟ من سينقذ اللاجىء؟
الجميز- شجرة الجميز رمز للفرج الآتي، حيث سيتم مخاض اللاجىء تحت هذه الشجرة؛ ليولد من جديد في وطنه.
أمّا بالنسبة للسارد أمين فهو يمثل حسب رأيي الفلسطيني الذي يحافظ على ذاكرة الأجداد، وينقلها من جيل لآخر،والذي يحمل الهمّ الوطني والصراع حول القضية.
الجدّة،هي رمز لحفظ الذاكرة الفلسطينية التي لا تنسى.
أمّا بالنسبة للأسلوب الواقعي، فقد قام السارد أمين في مواكبته لمواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ومراسلته الباحثة داليا، ونقله الواقع.
رواية ليست سهلة في تركيبها، قام الكاتب بمجهود كبير في سرد روايته، بورك العطاء والإبداع.
وقالت رفيقة عثمان:
نسج الكاتب روايته التي سيطر عليها الخيال الجّامح، حول تقفّي آثار الصّامت، او المنسي الفلسطيني جدّ الرّواي، والّذي سطّر بطولات غير عاديّة ضد المحتلّين الصهاينة والإنجليز في فلسطين، واختفت آثاره عن أعين مطارديه الصهاينة والإنجليز.
من هنا تبيّن لنا الزّمن الّذي اختاره الكاتب للرواية عنه، مستخدمًا أسلوب الإسترجاع الفنّي في الرّواية، برأيي هذا الأسلوب في استخدام الاسترجاع غير موفّق.
إنّ أحداث الرّواية تأخذ القارئ نحو التّوهان؛ نظرًا لتكرار الأحداث المُتلاحقة، وخوض المعارك المختلفة مع المُحتل مرارًا وتكرارًا، ممّا بعثت على الملل، وعدم القدرة على متابعة الأحداث؛ لانتقال الراوي مع الشخصيّة المُرافقة “داليا” التي هدفت للوصول لفك رموز المخطوطة، بالتعاون مع الرّاوي حفيد المنسي.
إنّ الخيال الجامح الّذي نهجه الكاتب غلب على الحقائق التّاريخيّة المُنتقاه؛ لتأريخ فلسطين، وخوض المعارك الباسلة ضد المحتلّين، وكان دور “الصّامت” دورًا غير عادي، بل هو شخصيّة أسطوريّة لا تُهزم، ولا تعرف الموت أو الاستسلام، في كل مرّة يحيا بعد الموت ويستيقظ من جديد كالفينيق، ويحارب حتّى النّهاية.
يبدو لي بأنّ هنالك مبالغة في عرض صورة البطل الأسطوريّة، والّتي هي بعيدة كل البُعد عن الحقيقة؛ إلّا أنّ مُراد الكاتب هو تجسيد البطولة الفلسطينيّة وتخليدها كرمز خالد للمناضلين الفلسطينيين.
في نهاية الرّواية، لم يكن اختيار الكاتب للمكان الّذي وصل إليه الصّامت واختار أسوان في جنوب مصر ليكون له مسكنا؟ هل أراد الكاتب أن يُقحم مصر في روايته؟ أم أراد تكريم مصر بوجود الصّامت فيها، وانخراط مصر في الدّفاع عن فلسطين؛ خاصّةً بعد أن خاض الصّامت المعركة مع الزّعيم جمال عبد النّاصر في الفالوجة، وإنّ طلب الصّامت أن يسكن في أسوان لم يوضح الكاتب مبتغى الصّامت لهذا الاختيار.
يبدو لي بأنّ الكاتب متمكّن من المعرفة لتاريخ فلسطين السّياسي والاجتماعي، فازدحمت الأحداث بشكل متواصل، وتعدّدت الأماكن، فانتقل الكاتب بين الأماكن المختلفة والبعيدة المسافات فيما بينها؛ هذا الأسلوب، يفقد التشويق لقراءة الرّواية.
امتازت اللّغة بالبساطة، والبلاغة الجميلة، والوصف الرّائع للأماكن والأحداث. استخدم الكاتب لغة الحوار والّتي اعتمدت على شخصيّتين، شخصيّة الرّاوي والبطلة “داليا”؛ وقلّ الحوار الذَاتي في الرّواية.
أنوّه بأنّه وردت أخطاء لغويّة ونحويّة وأخطاء مطبعيّة عديدة، كان من المُمكن تلافيها؛ ومن المفضّل مراجعة نصوص الرّواية وتنقيحها قبل نشرها، خسارة جدّا الوقوع بهذه الإشكاليّة الهامّة.
خلاصة القول: حملت هذه الرّواية في طيّاتها رموزا متعددة، وأتاحت للقارئ تفعيل الخيال والتفكر في حل رموزها وأحجيتها.
هذه الرّواية تستحق القراءة، وهي إضافة نوعيّة للكتابات التأريخيّة، والّتي توضّح النضال للشعب الفلسطيني العصور، وتخطيط البطولات الّتي اشتهرت بالدّفاع عن فلسطين وحقوقها، أمام المحتلّين الغاصبين.
هذه الرّواية مجّدت الصمود الفلسطيني، والتي رمزت بأنّ قضيّتها خالدة وحيّة، ولم تُنس أبدًا، مثل المنسي أو الصّامت في الرّواية.
وقالت نزهة أبو غوش:
في روايته الصامت، اجتهد الكاتب التلولي أن يكتب الرّواية الفلسطينيّة متفرّعا بالزمان والمكان دون حدود؛ حيث تنقّل بشخصيّاته عبر الأزمنة المختلفة منذ عهد القسّام والحسيني، وعهد الانتداب الإنكليزي والاحتلال اليهودي مستخدما الخيال الجامح كوسيلة تقنيّة، نحو استعانته بالأرواح المتنقّلة من شخص لآخر، ومن مكان لمكان، وخاصّة تأثير تلك الأرواح على سلوك الأشخاص مثل الخوف والرعب.
كانت روح الصّامت مؤثّرة على الكثير من الشخصيّات، كذلك روح ولده الشيخ سلامة وحفيده المنسي من بعده. كانت لعنته تصل لكلّ مكان. من بين القبور وغيرها.
في الرّواية نجد أنّ الواقع قد اختلط بالخيال؛ فهي وسيلة لاجتياز الزّمن والمكان، مثلما ذكرت عن الأرواح أعلاه، حيث عبر بنا الكاتب معظم البلدان في فلسطين، وخارجها لبنان وأسوان جنوب مصر.
تعدّدت أسماء بطل الرّواية، البطل المحارب المجاهد؛ من أجل فلسطين فهو تارة الصّامت وتارة المنسي، وتارة الشّيخ سلامة – حارس المقبرة-
تنقّل من الماضي حتّى يومنا هذا جسدا أو روحا؛ لذلك نلحظ اختلاط الماضي بالحاضر، ربّما أراد الكاتب أن يذكر بأنّ ما يحدث اليوم في فلسطين هو امتداد للماضي؛ وأعتقد بأنّه انتقى أسماء شخصيّاته؛ كي يجسّد من خلالها الوضع الفلسطيني على مدى التّاريخ، حيث أنّ شخصيّة الصّامت تغبّر عن الصّمت العالمي عن القضيّة الفلسطينيّة وأحداثها وأبعادها ومخلّفاتها السّياسيّة والاجتماعيّة والتّاريخيّة. أمّا شخصيّة الشّيخ سلامة الكفيف، فربّما قصد بها عمليّة السّلام غير الناجحة، فهي كالرجل الكفيف الّذي لم يبصر النّور، أي الحقيقة؛ أمّا المنسي فقد تعدّى بها من الصّمت والسّلام الفاشل إِلى النّسيان تماما، وهذا ما يعمل عليه العالم اليوم بكدّ وجهد؛ كي ينسى الإنسان الفلسطيني، ليس قضيّته فحسب، بل وجوده وكيانه.
ربّما شكّلت شخصيّة الجدّة القليل من الأمل، حيث أنّها حتى آخر لحظة ظلّت تأمل بوجود زوجها المنسي حيّا يرزق.
أرى بأن صديقة الرّاوي، داليا الباحثة عن مخطوطة المنسي تمثّل هؤلاء المراوغين والمقايضين الّذين ما زالوا يوهمون العالم بأنّهم يعملون من أجل القضيّة الفلسطينيّة.
المخطوطة تمثّل الضّياع، الّذي هو نتاج للعناصر الثّلاث: الصّمت، السّلام الكاذب، والنسيان.
أمّا جذع شجرة السنديان؛ فهو البقاء والرّسوخ في الأرض؛ رغم كلّ الصّعاب والمعيقات.
لا أعرف لماذا جعل الكاتب مرقد البطل في أسوان مصر، وليس في فلسطين؟ ربّما لإِظهار دور مصر الإيجابي، في زمن الرّئيس الرّاحل جمال عبد الناصر.
وقالت رائدة أبو الصوي:
حفيد المنسي . متى ياتي المتحدث؟ المنسيون الفلسطينيون في أصقاع الأرض
الذين ذاقوا المرّ في الشتات كانوا حاضرين في الرواية ما بين السطور،
قبل أن نصاب باللعنة وكم مرة كرر كلمة اللعنة. الجدة صفية وحضورها القوي المؤثر، ذكريات عاش معظم الشعب الفلسطيني أحداثها .
سرد جميل لأحداث قاسية ، بانوراما اخبارية. الحياة قبل اللجوء وبعد اللجوء،
مدارس الوكالة ومعونات الوكالة، ألفاظ من اللغة المحكية استوقفتني مثل :
فِزِّن، كانت ستي الله يرحمها تستخدمها كثير ، فزّي قومي ، دلالة على النشاط والحركة بركة أي قومي بسرعة، وخريفية، البئر، في نص ، يا لنظرتي التي نظرتها الى قاع البئر، أعادت ذاكرتي للوراء لبئر جدتي ولحظات التأمل،
عندما كنت ألقي الدلو في البئر واستمتع عندما استمع لصدى صوت الدلو، يصطدم بوجه الماء وتنبعث رائحة الطحالب من جدران البئر أشعر بالسعادة والهدوء.
معظم البيوت القديمة كان في ساحتها بئر أيام الخير.
في الرواية تناص في أكثر من نص مثال على ذلك:
ذات اليمين وذات الشمال ، ولا تقصص رؤياك..إلخ.
طرح قضية …عقدة في الرواية وهي موضوع المخطوطة، وزائرة الليل، رموز لها ما وراءها .
تخيلت المخطوطة القضية الفلسطينية وزائرة الليل فلسطين، التي يحلم بها والعودة اليها أهلنا في الشتات ، أهلنا المعذبون بالأرض
شجرة الجميز وحضورها بالرواية اختيار ذكي، تلك الشجرة دائمة الخضرة
الشجرة المقدسة عند الفراعنة والتي تعتبر رمزا للقوة والخلود والبعض يعتبرها من طعام الجنة. فلسطين كالجميزة والجميزة لها فوائد كثيرة من أهمها أنها تطلق كمية كبيرة من الأوكسجين لذلك تزرع في الحدائق.
الرواية تفتح الآفاق ، الاثواب الفلسطينية الجميلة كانت حاضرة .
في الرواية توثيق تراثي ، وفيها إثارة خصوصا في نص ص 128، خروج الافاعي من بين تصدعات الكهف، تخيل أن تكون في موقف كهذا .وقف تعرض له معظم ثوار فلسطين ،موقف تعرضه للاعتقال من الانجليز.
المخطوطة أيضا تدل على وعد بلفور المشؤوم، لندن وما وراءها، مصر أمّ الدنيا كانت حاضرها بصخبها وحضور أهلها الطيبين،
رواية البحث عن الذات وعن الحكاية في مخطوطة، البحث ليس ماديا بل معنويا،
مخطوطة الشعب الفلسطيني الذي عانى ولا زال يعاني وينتظر الفارس القادم على حصانه الأبيض .
اسم الصامت والمنسي لم يأتيا صدفة ولا عبثا ،بل هناك غاية في نفس الكاتب.
وكتبت ابتسام خالد:
رواية “الصامت” من شجرة جميز تقطر كلمات.
من المدينةِ التى تغفو على كتفِ موجة عنيدة، وتأبَى الغرقَ في لُجِّ العتمةِ؛ تقاومُ نحو النورِ، تشق للشمسِ ممراتٍ من بين أسوارها لتبقى على قيدِ الحياة؛ زهرةُ الجنوبِ شامخةٌ بالعزةِ والكرامةِ؛ مهما فعل المارقون؛ غزةُ بوابةُ النصرِ الأكيدِ؛ من بحرِها هبت نسائمُ تحملُ لي ١٧٦ ورقةً من شجرةِ توتٍ تقطرُ كلماتٍ من إبداعٍ موشحةً بغلافٍ أصل الحكاية ( الصامت )؛ روايةٌ خرجت من عنقِ الزجاجة.
تتكرّرُ ظاهرةُ الإعلاميين والصحفيين الذين مزجوا عبر رحلتهم الإعلام بالسياسة والأدبِ، وها نحن الآن أمام أديبٍ حلق في فضاءِ الإعلامِ والسياسة والأدب، ودأب يكتبُ ويُصدِرُ رواياتٍ بقلمهِ الذي يراودُه بشغف الأفكار؛ (الصامت) روايةٌ بقلم الكاتبِ شفيق التلولي؛ شخصيةٌ اعتباريةٌ من غزةَ؛ ابنُ مخيّم جباليا حاصلُ على الماجستيرِ في العلوم السياسية، ويحضر لمناقشة رسالة الدكتوراة، عضو الأمانة العامة للاتحادِ العام للكتابِ الفلسطينيين، عضو المجلس الوطني الفلسطيني وعضو لجنة الفكر والإعلام بالمجلس.
في بدايةِ الأمرِ وجدتُ الإهداءَ قادني إلى الأجداد والجذورِ، وما تركوا لنا من إرثٍ وذكرياتٍ وحكاياتٍ؛ حفرت في داخلنِا بصمةَ الحكايةِ التى ما زالت تدقّ ضلوعَ الذاكرةِ ألما منذ سبعةٍ وسبعين نكبةً، فكان الإهداءُ في روايةِ (الصامت) دلالةً على مضمونِ الفكرةِ التي هي روحُ الحكاية ومن ثَمَّ استهلَ الكاتبُ بدايةَ الروايةِ.
أوّلُ الصفحات
ص١١ بدأت بلغةٍ عميقةٍ تعبيريةٍ، وتشبيهاتٍ قويةِ المعاني؛ لا يسكبُها إلا قلمٌ رصينٌ؛ ورحت أبحرُ في أعماقِ الروايةِ حيث غرقتُ في عالمٍ من الخيال والواقعِ معا ..فنتازيا..وصفٌ وتوثيقٌ..شخصياتٌ أسطوريةٌ وواقعية؛
الكاتبُ هنا يحملُ فكرةً فقام بكلِ أدواتِه، وما يحملُ قلمُه من تجربةٍ حتى يوصلَ الفكرةَ الكامنةَ بداخلهِ إلى العالمِ الخارجي؛ حيث أخرج غزةَ من جلبابِ الحصارِ إلى خارجِ الحدودِ بقصتهِ الأسطورية، وحكاياتِ الأجدادِ؛ قصةُ جدّهِ الصامت مع شخصياتٍ حاورَها بسردِه المتدفق خلال فصولِ الروايةِ، وتأخذُ الوصفَ العميقَ مصطحباً خيالَه الواسعَ نحو الأماكنِ، والأحداث، والعصورِ التى مرت بها الأحداثُ، حيث يمرُ بالبوابةِ الجنوبيةِ من رفح المصريةِ حتى المنطقةِ الشرقيةِ التى ترتبطُ بغزةَ ارتباطاً تاريخياً، ومرّ في أزمانٍ وشخصياتٍ تاريخيةٍ، لقد استطاع الكاتب هنا أن يخرج رواية متكاملة بقلمه الناضج.
من هنا وبعد أن أنهيت قراءتي لرواية الصامت .. كقارئ ومهتم.
يراودني سؤال من شِقّين..هل سيكون الكاتب التلولي نموذجا من هؤلاء الإعلامين الذي أصبحوا من عمداء الأدب.
أم سيكون كاتب رواية وصفية وتوثيقة (مؤرخ)، هذا السؤال تكون عليه الإجابة في الأعمال القادمة للكاتب.
وكتب رائد محمد الحواري:
عندما يجمع النص الروائي ما بين الأسطورة/ الحكاية وبين الرواية، فهذا أمر يحسب للكاتب وللرواية، التي مزجت ما بين ما هو شعبي/ تراثي، وبين ما هو حداثي/عصري، عندما تأتي الأسماء لتخدم فكرة الرواية فهذا يضيف ميزة أخرى للرواية، وبما أنها تتحدث عن فكرة التوحد/ الحلول الصوفية من خلال “الصامت، سلامة، المنسي” ومن ثم تربطه بالمخطوطة، وبالشجرة، ثم تجعله أحد أبطال المقاومة، فهذا يجعل الرواية تجمع بين الحكاية (الشعبية) وبين حقائق حدثت على الأرض.
فهناك تشابك بين المخطوطة وبين الشجرة، وبينهما وبين “أمين” السارد، وبينه وبين أجداده “الصامت وسلامة والمنسى”، بحيث نجد حلولا ما بين الصامت والمنسى، وبما أن هناك أكثر من مقام للصامت، فإذا جعل فكره/ كرامته تنتشر وتتوزع على أكثر من مكان، ومن ثم أصبح يمثل (أسطورة) شعبية يتداولها الناس.
السارد وكتابة الرواية
بما أن الرواية تتحدث عن فكرتين/حالتين، الحكاية والرواية، الماضي والحاضر، فقد استخدم السارد مدخلا أدبيّا يقنع المتلقي به، ففي بداية الرواية يكسر وتيرة السرد من خلال قوله: “لا أدري لماذا تطلّ عليّ جدتي، ترميني بشريط حكاياتها القديمة كلما اجتاحني طيف الكتابة، … تأخذني إلى عوالم أخرى لا أدري كيف أسافر معها وأغوص في مداراتها؟ فأنصرف عن استئناف مشروع روايتي وأهيم مع ذاك المنسي الذي بات يزورني في يقظتي وأحلامي” ص22، في هذا المقطع يلخص السارد ما جاء في السابق عن عملية التوحد/التشابك/التداخل بين شخصيات الرواية وبين الماضي والحاضر، وهذا (الصراع) بين الحكاية/الماضي وبين الرواية/الحاضر الذي استمر حتى نهاية الرواية، ولم يتم حسم الأمر فيه، وكأن السارد لم يرد أن ينهي فكرة التداخل/التشابك/التداخل في الرواية، وهذا يشير إلى أن فكرة الحلول/التوحد، فكرة مفصلية وأساسية في الرواية.
لكن هذا الحلول/التوحد لم يأتِ بسهولة، بل بدأ وكأنه حالة مخاض/صراع/ألم قاسي يعانيه السارد: “أمسكت بقلمي، كلي إصرار على استئناف روايتي التي قطعت على نفسي عهدا أن أكملها، ما إن لامس حبر قلمي رأس الصفحة حتى أطلت جدتي توشوشني: “ألا أكملت لك حكاية جدك الصامت؟” …وضعت قلمي جانبا، طويت أوراقي، غلبني النعاس، ألقيت برأسي على مكتبي واضعا يديّ تحت جبهتي، وإذا فتاة تهزني وتهمس في أذني: “جئت لك من بلاد بعيدة أحمل في جعبتي كنوزا ثمينة جلبتها من صندوق العجب بعد أن وجدته على شاطئ بحر عتيق” ص24و25، نلاحظ أن هناك تداخلا بين كتابة الرواية والحكاية، الماضي والحاضر، بين الصامت والسارد، بين حكاية الجدة والفتاة التي خرجت له، بين الحلم والخيال، وهذه الإثارة جعلت المتلقي يبقى متعلقا ومتابعا لأحداث الرواية.
يتقدم السارد خطوة مقربا بين الخيال الواقع، بين الحكاية وبين والرواية، من خلال “دالية الكرمي” الباحثة التي راسلته: “..أنا معك أيها الكاتب، أقرأ ما تكتبه بتمعن، لكني لا أخفيك سرا أني مصابة بالذهول، فكأنك تروي لي أسطورة من أساطير الأوّلين، كيف بالله عليك أن أمضي لمقام جدك الصامت وأخاطبه، فيكلمني بعد أن مات منذ مئات السنين” ص34و35، وكأن السارد من خلال ما تقوله الباحثة يريد الإجابة على تساؤلات القارئ، الذي يرى/يلمس أن هناك (عدم منطق) فيما يطرحه من أحداث ويقدمه من شخصيات، فحالة الحلول/التوحد لا يمكن أن يقتنع بها القارئ من أول مرة، فكان لا بد من إثارة الأسئلة والتساؤلات على لسان شخصيات جديدة في الرواية، فكانت “دالية الكرمي” تتحدث بالنيابة عن القارئ: ” أراك سرحت حضرة الكاتب، وأراني أهيم في عالمك المتخيل، أنا لا قدرة لي أمام فهم رؤيتك للعالم وقدرتك على توظيف الخيال لصالح الواقع” ص60، بهذا الشكل استطاع السارد أن يضع تساؤلات القارئ ضمن بنية السرد الروائي، وفي الوقت ذاته يقربه من الفكرة الحلول/التوحد التي يطرحها.
الصامت والمنسي
قبل الدخول إلى طبيعة الشخصيات الرئيسية ” الصامت، سلامة، المنسي” نتوقف قليلا عند معانيها، فنجد في الأول الهادئ/الحكمة، وفي الثاني المسالمة، والثالث المظلومية، وهذا يخدم فكرة واقع الشخصيات التي أراد السارد الحديث عنها، فهي تتماثل مع واقع الفلسطيني وحالة الهدوء/السلام/الظلم الذي وقع عليه.
وإذا أخذنا اسم السارد “أمين” الذي أوصل لنا ما جرى من أحداث، وعرفنا على هذه الشخصيات، يكون قد أوصل الأمانة وأوفى عهده لأجداده، “الصامت، سلامة/ المنسي”، وهذا ما يجعل الأسماء تخدم فكرة الرواية، خاصة إذا عرفنا أن اسم الباحثة “دالية الكرمي” ودورها المكمل لدور “أمين” نتأكد أن معاني الأسماء لها دلالة في خدمة فكرة الرواية، وأرادها السارد لتكون داعمة لمضمون الحلول والتماهي مع الرواية.
فمعنى الصمت/”الصامت” يخدم فكرة المسالم/”سلامة”، وأيضا “الصمت/الصامت هو مقدمة وتمهيد للنسيان/”المنسي”، وبما أن هناك شخص أوصل لنا وعرفنا عليها فهو “أمين.”
“الصامت” عنوان الرواية والشخصية المركزية فيها، لكن بعد متابعة الأحداث والشخصيات نجد أن هناك شخصا آخر أخذ مكانه في الأهمية هو “المنسي” الذي تحدثت عنه الرواية أكثر بكثير مما تحدثت عن “الصامت”، لكن السارد يفاجئنا في نهاية الرواية بفكرة المزج/الجمع بينهما، لكن بداية التوحد بين الصامت والمنسي لم تأت مرة واحدة، بل من خلال مجموعة أحداث/مشاهد، منها: “حتى سمع همسا”.
ـ منذ ذلك الحين سيكون المنسي خليفتي من ذريتي، سيكون صاحب حظوة، ستجدونه في كل مكان، لن يكون بمقدور أحد أن يغلبه بسهولة، لا تجعلوه يغضب فتحط اللعنة” ص81، هذا ما تحدث به “الصامت” لابنه “سلامة”، أو ما تخيله سلامة، وكما جاء الصامت لسلامة جاء للمنسي، وبعين الطريقة، التخاطر/التخيل: “..استيقظ على همس الصامت، سمع خطاه بينما يغادر منامه، لم يتمكن من فهم ما ألمح إليه، غير أنه التقط بعض كلمات تذكرها بعدما استيقظ مرتجفا، كانت آخر ما نطق بها:
ـ لا تترك هذا المكان أو تبتعد، إن حدث وتركته، فلتعد وحتى تعود قلها ومت، قلها لتعد.
انطلق المنسي عائدا إلى بيته في جعبته وصية الصامت، قبل أن يحط بفرسه في حاكورة الدار، عرج إلى المسجد يصلي العصر خلف أبيه الشيخ سلامة، ويقص عليه عساه يفسر له ما رأى فقال له:
ـ لا تقصص رؤياك على أحد إلا بعدما يعود الصامت من كبوته أو يبعث رسولا، فالرؤيا عند الظهيرة سرّ، وكشف السّرّ فأل غير محمود، لا يحق إلا بعدما يعود المرئي للرائي” ص93، نلاحظ أن هناك حلولا/تداخلا بين شخصيات الابن والأب والجد، حتى إننا نجدهم يتشاركون فيما بينهم، وهذا يخدم فكرة الحلول والتواصل بين سلالة “الصامت”، فقول: “لا تقصص رؤياك على أحد” لا ندري من قاله، هل هو الصامت أم ابنه سلامة!، وهذا ما يؤكد على فكرة الحلول/التوحد بين شخصيات الرواية.
الرواية تمزج الشخصيات، وتجعلها تتشارك في تكملة من أنجز من أفعال وأعمال، فهناك تكامل بين ما قام به “الصامت” وبين ما سيفعله “المنسي: “في بلاد لا تبعد كثيرا عن هذه الأرض، يخرج من ذريتي منسي من بئر، يُشرد الذين كانوا يردون نبعها، لا يلتفتون إليها، يغور ماؤها، يجف حلق المنسي وهو ينادي:
أنا المحكي والحاكي، أنا هناك، حتى يبح صوته” ص106، هذه النبوءة التي كتبها “الصامت” في المخطوطة، متعلقة به وبالمنسي ومتعلقة ب”أمين” السارد الذي ينقلها لنا، وإذا ما توقفنا عند هذا المشهد، نجد أن (حكاية الصامت) تتغلب على الرواية، فهي من يسيطر على الأحداث، حتى أن “أمين” السارد تخلى عن كتابة الرواية وأخذ ينقل ما هو متعلق “بالصامت”، وكأن الماضي/الصوفي حل على الحاضر وسيطر عليه، بحيث لم نعد نرى/نلمس/نقرأ أحداثا متعلقة بالسارد “أمين”، فقد اندمج/توحد مع أجداده “الصامت، سلامة، المنسي”، ونجد هذا الأثر يتجاوز (التخيل) ليمسي حقيقة يعيشها “أمين”، فبعد أن يصل إلى مقام جده الصامت، يصاب بحالة من العجز بحيث لا يقدر على التقدم خطوة واحدة في المقام: “… لم أعد قادرا على الحركة والمشي نحو المقام، غير أني أشرت إليها بالدخول إلى المرقد بمفردها بعد أن عجزت قدماي عن التقدم والمسير وصولا إليه، ما أن مضت وغادرتني، حتى همس في أذني هاتف: “عد بخطاك إلى الخلف، لا تعد إلي قبل أن يستريح المنسي الذي ساح في الأرض صامتا …أرح المنسي ثم عد” ص160و161، فهنا لم يعد هناك راو يريد أن يكتب روايته، بل هناك شخص غارق في الأحداث التي حوله، بحيث لم يعد يقدر على الحركة، ولا على التفكير بغير “الصامت والمنسي” والهاتف الذي سمعه من جدّه الصامت، يؤكد على أنه أصبح يخضع بشكل كلي للصامت والمنسي، ولما يوجد في المخطوطة.
المخطوطة والشجرة
هناك وحدة/حلول بين الصامت وبين المخطوطة التي كتبها، فهي تمثل تاريخ أجداد “أمين” السارد، وهي بمثابة الرسالة/الوصية لما يريده الصامت: “..لا تفرط بهذه المخطوطة، لما لها من أهمية، إنها أمانة أجدادي ووصية الصامت وخريطة الطريق لذريتنا ونسلنا من بعدنا” ص53، هذا فيما يتعلق بالمخطوطة، لكن هناك شجرة الجميز التي تم وضع المخطوطة فيها، حتى أنهما ـ الشجرة والمخطوطة ـ أصبحا يمثلان جسما واحدا: “…أن يحافظ على المخطوطة، وأن يحرص على دوام الاعتناء بشجرة الجميز، وأن يحفظ المخطوطة في جذعها السميك” ص75، من هنا عندما يتم إخراجها من الشجرة، يعمل المنسي المستحيل لإعادتها للشجرة.
أحداث الرواية
رغم أن الرواية تتحدث كثيرا عن المخطوطة والشجرة والمنسي والصامت، إلا أن هناك أحداثا واقعية تتناولها، وكلها تتحدث عن فلسطين وما مرت به من اضطهاد وظلم على يد كل من حكمها، من الأتراك: “..بمساعدة المقاتلين الذين ملأوا فلسطين في تلك الأثناء بعد أن علموا بأسره وهبوا جميعا لتخليصه منهم، ظل مختبئا في مغارات جبال فلسطين، حتى تسلل إلى دمشق، وانضم للمقاتلين السوريين الذي خاضوا معارك ضارية مع الأتراك بسبب الظلم والطغيان الذي مورس عليهم، كما مورس على فلسطين” ص76و77، مرورا بالإنجليز: “حاصرت القوات البريطانية القدس، وطالبت المنسي بالخروج إليها وتسليم نفسه فرفض هو ورفاقه المقدسيون وأهل الخليل ونابلس، وكذلك المسيحيون وقرروا الدفاع عن المدينة المقدسة والتصدي للقوات المحاصرة” ص111، وكذلك الحركة الصهيونية وما فعلته من تدمير وتخريب وقتل في فلسطين: “..معبر إيرز” المقام على أراضي بلدة “دمرة” الفلسطينية المحتلة” ص122، كما أنها تناولت ثورة القسام ودوره في تأسيس العمل الفدائي الفلسطيني: “…فلم يكن يتمكن أحد من الالتحاق بها إلا العضو الذي يقتني السلاح على حسابه الخاص، وأن يتبرع للعصبة بما يستطيع، وكذلك يجب أن يبادر بالضربات الخاطفة للإنجليز وقوافل الهجرة اليهودية القادمة لفلسطين” ص136، من هنا يمكننا القول أن السارد استطاع أن يضمن الرواية أحداثا حقيقة، بحيث مزج بين المتخيل/المخطوطة/الصامت، وبين أحداث وشخصيات حقيقية، وهذا ما جعل القارئ يصل إلى فكرة الظلم/القهر الذي تعرض له الفلسطيني، وعلى استمراره في التمسك بحقه/بتاريخه/بماضيه، فتأثر “أمين” بالمخطوطة وما جاء فيها يمثل استمراره في نهج المنسي الذي ما زال يتداول قصته الناس، الذين جعلوه أسطورة تحيى في كل العصور والأزمنة.
وكتبت منال الزعانين:
كنت أحلم أن يعمل أحدهم عملا أدبيا ويذكر تلك القرية المنسية على أعتاب المغادرين والعائدين من دروب الوطن.
تلك القرية المهجرة بأراضيها وشجرات المشمش التي كان جدي يقطفها، ويذهب بها إلى حيفا، وشجرة الجميز العتيدة التي ذكرها الكاتب شفيق التلولي في روايته الأخيرة “الصامت”، وتلك البئر المشؤومة الذي ألقى فيها اليهود مجموعة من أهل البلدة الذين رفضوا المغادرة.
إنها رواية تعود بي إلى تلك الذكريات وذلك المكان لتحيي لنا ذكريات كنت أظنها في طريقها للإندثار، رواية ربطت الحاضر بالماضي والذكرى بالمستقبل بطريقة سلسة ورائعة وهادئة.
تلك الجدة التي اختزلت كل الأحداث في ذاكرتها عبر السرد الروائي مثلت كل الذين غادروا البلاد وعاشوا معها وحدثوها.
وكتبت جميلة شحادة:
لن أخفي أنني وقعت فريسة السؤال: ماذا يريد أن يقول المؤلف لقرائه؟ كلّما تابعت القراءة صفحة تلو الأخرى من رواية “الصامت” الى أن أنهيت قراءة الصفحة الثالثة والعشرين منها. في هذه الصفحات، بدا لي أن الكاتب يتخبط، وهو في حيرةٍ بين متابعته لكتابة إحدى رواياته التي بدأ بكتابتها، دون أن يصرّح عن موضوعها أو عنوانها لقرائه، وبين هواجسه التي تزوره في الكرى وفي يقظته أيضًا. وهنا أظن أن الكاتب بفِعله هذا، كان يحاول الكشف للقرّاء عن تقنية سرده للرواية، وهي الدمج بين الأسطورة والواقع، ويبذل جهدا ليوصل لهم ماهية العلاقة بين حكايا جدته ومخطوط جده الصامت؛ لينطلق منها الى حكايته مع الباحثة دالية الكرمي، التي تعرّف عليها من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي. بدا الكاتب في سرده للأحداث في الصفحات الأولى من الرواية، قليل الصبر، فجاءت كتابته للأحداث سريعة ومتسارعة، مكثّفة، قصيرة؛ فما أن يلبث القارئ بالتقاط طرف الحدث، حتى ينقله الكاتب الى حدث آخر. لقد كشف أسلوب السرد هذا، عن اهتمام الروائي بتوصيل الفكرة المركزية، أكثر من الخوض بالتفاصيل المسهبة، ووصف العلاقات والأحداث وجغرافية المكان. فهو موجهٌ نحو تحقيق هدفٍ، وتوصيل رسالة من كتابة الصامت. لذا فقد خنق الروائي أصوات شخصيات الرواية، وأبقى على صوت البطل أمين، الذي هو صوته، وراح يتكلم باسم شخوص روايته. فها هو على سبيل المثال، يحدثنا عن حكايا جدته، وعن رسائل دالية وغير ذلك؛ دون أن يفتح حوارًا بينه وبين شخوصه الّا ما ندر. على أي حال، أسلوب السرد هذا ليس بالضرورة أن يُحكم عليه سلبًا، وللروائي الحق كله في اختياره تقنية السرد الملائمة لبنية عمله الروائي.
لقد اختار الكاتب شفيق التلولي “الصامت” عنوانا لروايته، وهو كما جاء في الرواية، اسم أحد أجداد بطل الرواية أمين. والصامت لغويّا، هو اسم فاعل للفعل “صمت”، وهو أيضا نعت للذي يقوم بفعل الصمت. ويقال:” ربّ صمتٍ أبلغ من الكلام”. فجاءت “الصامت” بقلم التلولي كاشفة الكثير. حيث كشفت رواية “الصامت” عن ماضي شعب يعيش فيه، وسيبقى يعيش في ذاكرته، وما زال مؤثرا في واقعه. ومن هنا جاءت قيمة الرواية، برأيي، حيث أنها تعتبر وثيقة وثّقت حقبة تاريخية، ووثّقت مطالب شعبٍ لم تتحقق بعد.
لقد اختار الكاتب التلولي “الصامت” عنوان روايته رغم أن الشخصية المركزية في الرواية هي شخصية الجّد “المنسي”، فهل لهذا دلالة عند المؤلف؟ برأيي نعم. لأن لمعاني أسماء الشخصيات في العمل الأدبي، دلالة يوظفها الكاتب؛ لترمز وتشير إلى فكرة ما. فلم يختر التلولي “المنسي” عنوانا لروايته، لأنه يوثق تاريخا يريده أن يظل حيّا في الذاكرة ولا يريده أن يُنسى.
تدور رواية “الصامت” حول شخصية “المنسي”، الذي لم يُعرف مصيره في الرواية، فهناك من يعتبر أنه قُتل، وهناك من يعتبر أنه ما زال حيّا. “سرد أحد كتّاب الإنجليز حكاية المنسي في معرض روايته، ادّعى أن المنسي قُتل في تلك المعركة قبل أن يقع في قبضة القوات الإنجليزية، ومن ثمّ نفخ اليسوع الروحَ فيه فانبعثت من جديد، وفي رواية أخرى قيل إنه انبعث من رماد العنقاء بعدما احترق.” ص 109. وهنا، قد يسأل القارئ: هل قصد الكاتب التلولي بالمنسي قضية فلسطين؟ على اعتبار أن هذه القضية اليوم غير معروف مصيرها بالضبط. هل ما زال قلبها ينبض بالحياة رغم كل محاولات خنقها؟ هل ما زالت موجودة في ذاكرة وضمير العالم رغم كل المحاولات لطمس ملامحها لتصبح منسيًا؟” لاحظ المنسي خروج الأفاعي من بين ثقوب تصدعات الكهف، أدرك الخطر الذي يحدّق به فقد تلدغه أفعى أو تنهار على رأسه حجارة الكهف، أو تتحطم الجبال وتبتلعه المغارات، فيصبح نسيًا منسيّا.” ص 128 فمَن هي هذه الأفاعي التي بطبعها الغدر؟ وكيف بإمكان القضية أن تصبح نسيًا منسيّا وهناك “المخطوطة” كما جاء في رواية الصامت والذي ترمز برأيي الى حق الشعب الفلسطيني بأرضه، فالمخطوطة هي إثبات خطي ووثيقة مكتوبة تؤكد حق الشعب الفلسطيني، ولو أصبح هناك اليوم مَن لا يجيد فهم كل الذي في المخطوطة، ولعل هذا يعود الى إحداث التزوير فيها. هذا ما يؤكد لي أن يكونوا قد زوّروا ما جاء في المخطوطة، الأمر الذي لن يفيدنا كثيرًا في البحث أو يضللنا فلا يمكننا من الوصول للحقيقة، التي تفسر لنا سر المخطوطة ومصير المنسي… ص 140.
إذن، الروائي شفيق التلولي بروايته “الصامت” أراد أن يسّلط الضوء على قضيةٍ لا تموت بمرور الزمن، وأراد من خلال “الصامت” أن يصرخ مطالبًا بحق شعبٍ لم يُنصف، أراد أن يتمّ البحث عن مصير “المنسي” من خلال اكتشاف التزوير في المخطوطة. فهو ابن غزة الصامدة، وقد اختار أن يحكي، ولو عن طريق الحكاية والأسطورة، عن واقع مُرّ، وعن شعب مقهور ينتظر الخلاص. أراد أن يحكي عن ظلمٍ ما زال مسكوتًا عنه.
وكتب يسري الغول:
الصامت ليست عملاً قصصياً أو روائياً غرائبياً لخورخي لويس بورخيس أو باولو كويهلو أو حتى لجابريل ماركيز، سيد الواقعية السحرية، وإنما رواية سحرية عميقة للروائي الفلسطيني شفيق التلولي، يعيش خلالها القارئ حكاية التاريخ والإنسان، يستلهم بخيوطها ظروف وأحوال المتخمين بالوجع، في عمل يكاد يكون الأول من نوعه على صعيد الأدب الفلسطيني الحديث.
ففي ركب الصامت المبارك يطير المتيقظون إلى حيوات المنسي المتعددة، في طرق كثيرة معبدة بالوحشة، مرورا بالشيخ سلامة وصفية، ثم مختار وزهية، الحاج عبد المطلب والخضر والعرافين، ووصولا إلى الكاتب وداليا، كي يدرك العارفون المقصد، ويكتشف القراء اللغز.
لقد عاش المنسي صامتاً فكان مريداً في حضرة الحياة والموت، وبانت معالم الأحجية، إنه الصامت بشحمه ولحمه، رغم تنقله من معركة لأخرى وبلد لآخر، ظلت عكا ويافا وحيفا أيقونة ترسم ملامح المعاناة التي يعيشها الفلسطيني.
الصامت عمل متخيل لا يمكن للقارئ أن يتركه إلا وقد انتهى منه دفعة واحدة، لنقل رفات الجد في البئر.
وكتب محمد نصار:
“الصامت رواية تربط بين زمانين متباعدين، أحدهم يعبر عن واقع الحال الذي نعيش والآخر يرجع قرابة قرنين من الزمان إلى الوراء، متتبعا سيرة “الصامت أو المنسي” إن شئت، المنسي الذي كان مركز الحكاية وحامل لوائها، فعبر دروب الحكاية الشائكة وسراديب الأسطورة المنبعثة من عمق التاريخ، نسج التلولي خيوط حكايته، مستعينا تارة بحكايا جدته، وما كانت ترويه في طفولته واختزنته الذاكرة، وتارة بما كان يرى في منامه من أحلام وتهويمات، يظهر فيها الصامت موجها سير الحكاية إلى الدرب الذي يريد، ثم عبر تلك الباحثة “داليا”، المتخصصة في علم المخطوطات والتي تواصلت معه من أجل إكمال رسالتها الدراسية، التي تعدها عن سيرة عائلة يعود نسبها لأحد أولياء الله الصالحين.
بهذه الخلطة السحرية بدأت رحلة الكتابة، التي تداخلت خيوطها وتقاطعت في أكثر من موضع، معطية الكاتب فرصة التحليق في آفاق رحبة وعوالم متباعدة، مكنته من القفز عن إشكالية الزمان والمكان في عمل تعددت فيه الأزمنة والأمكنة على نحو كبير، وربما مربك أحيانا، حتى أن القارئ قد تتداخل عليه تلك الأشياء وتتشابه، مما يضطره إلى قراءة العمل أكثر من مرة، لكي يقف على حقيقتها ويظل ممسكا بخيط السرد الذي يتعرج ويلتوي في أكثر من موضع.
فالرواية تبدأ بذلك الطفل المتعلق بجدته التي تبادله ذات الشعور، حتى أنها ترافقه إلى المدرسة وتنتظره إلى آخر الدوام، ثم تعود به إلى البيت، لتبدأ معه فصلا آخر من فصول سيرتها التي اعتادت أن ترويها على مسامعه كل مساء، عن حياتها في البلدة قبل الهجرة..عن مخطوطة أودعها جدّه المنسي لدى أخيه وأوصاه أن يحافظ عليها.. عن مرقد جده الأكبر “الصامت”، الذي كان يأتيها في المنام، طالبا منها زيارة مرقده، لكي يخبرها عن سر المخطوطة، التي دون فيها سلالته منذ عهود مضت..عن البئر التي تخرج أصواتا غريبة وعن الشجرة التي يزعم البعض أنها مسكونة.
كل هذا النسيج القائم على الأسطورة والخيال، كان عماد العمل الذي امتد لأكثر من مئتي صفحة من القطع المتوسط، حاملا على جناح الحكاية والفنتازيا، فكرة الكاتب، التي تشير إلى الجذور الممتدة عبر مئات وآلاف السنين في عمق هذه الأرض، مبرزا في ذات الوقت طبيعة الصراع الذي حدث بشكل تراجيدي متسارع، منذ حملة إبراهيم باشا، الذي جعل من المنسي أحد قواده البارزين، ثم من بعد سقوط الخلافة ودخول الانجليز إلى حلبة الصراع، بعد احتلالهم لفلسطين ودور المنسي في الدفاع والمقاومة من خلال مرافقته لعز الدين القسام ومشاركته في العديد من المعارك، التي دارت في سوريا ولبنان وحيفا وكان آخرها في الفالوجا، ثم رحيله مع عبد الناصر إلى مصر واختفاؤه هناك، حيث قيل أنه مات فيها وبنوا له مقاما في صعيد مصر.
عبر هذا الملخص السريع تدور أحداث الرواية وتتقاطع، حاملة على جناح الحكاية، سيرة ممتدة لأكثر من قرنين من الزمان وما زالت، مبرزة فصول المعاناة والفداء والبطولة، التي خاضها شعبنا أمام بطش الطغيان، الذي تمثل بكل القوى الاستعمارية التي تآمرت عليه وساندت هذا الكيان الغاصب.
صحيح أن الكثيرين من الكتاب الفلسطينيين لجأوا في الفترة الأخيرة، لتناول حقب زمانية مختلفة في أعمالهم الروائية، كنوع من التأكيد على الهوية والتاريخ، الذي بات مهددا أمام آلة الإعلام المعادية ودعم غربي واضح لتلك الرواية الزائفة، فكانت أعمال أحمد رفيق عوض “عكا والملوك” ، غريب عسقلاني أولاد مزيونة، محمد نصار “المبروكة و عبدو هيبا”، ابراهيم نصر الله في” قناديل ملك الجليل” والعشرات من الأعمال الأخرى، التي لا يتسع المجال لحصرها، إلا أن اعتماد التلولي في هذا العمل الروائي، على الأسطورة والخرافة وكل تلك الأجواء الفنتازية التي حملتها الرواية، جعلت لها نكهة خاصة ومغايرة، عما سلف ذكره من أعمال.
وكتب جواد العقاد:
“الصامت” رواية عالجت عبر عشرة فصول قضايا مهمة بقالب روائي غرائبي، مراوحة بين الواقعية والغرائبية بشكل متكافئ تكاملي من خلال تتبع المخطوطة المخفيّة، التي يبحث عنها بطل الرواية “أمين” والباحثة “دالية الكرمي”، وخلال رحلة البحث تناولت الرواية عدة موضوعات اجتماعية وتاريخية باستحضار شخصيات تاريخية مثل محمد علي باشا وابنه إبراهيم، والإشارة إلى الاستعمار التركي للوطن العربي الذي أغرق العرب في أربعة قرون من الظلام، وذكرت الرواية بعض المعتقدات الشعبية مثل التبرُّك بالقبور، فكانت إحدى الركائز التي انطلقت منها إلى الغرائبية أو الواقعية السحرية، وهذا ما جعل ترابط لا منافرة فيه بين الواقع والفنتازيا الذي جاء في محله من خلال المنام والمعتقدات الشعبية الخيالية، مما جعل مجرى الأحداث منطقيّا.
أما المكان في الرواية فعلى الرغم من تعدده ما بين فلسطين، مصر، الشام… جاء التنقل بين الأمنكة بربط منطقي جدًا، بحيث لا يتوه القارئ وهو يتابع صيرورة الأحداث، ولعلّ الفضاء المكاني في الرواية جاء من منظور الإيمان القومي بالوحدة العربية عند الكاتب، أو بالأحرى في كوامن نفسه، ويتوافق مع ذلك جعل الزعيم جمال عبد الناصر إحدى شخصيات الرواية.
وبالنسبة لأسماء الشخصيات فقد جاءت مناسبة لملامح الشخصية ( المنسي، الصامت، أمين، دالية..)، فمثلا: الصامت حفيد المنسي، هل يصبح منسيّا كجدّه إذا بقي صامتا؟ وهذا يعني أن وجود الإنسان يتحقق بموفقه. ولها دلالات ثرية إذا درسناها وفق المنهج السيميائي، وكذلك الإهداء “إلى جداتنا، أجدادنا.. جذر الحكاية”، وبخاصة تركيب ( جذر الحكاية) يرتبط جذريّا مع مضمون الرواية التي تمحورت حول شخصيات عاشت في الماضي في إطار متخيل، لكنه في الوقت ذاته يعيد فهم بعض المعطيات التاريخية وفق رؤية خاصة بالكاتب قائمة على الرغبة في إعادة فهمنا للذات الإنسانية أوّلا، والواقع المعاصر ثانيا، فما هذه المخطوطة الضائعة أو بالأدق المخفيّة سوى تاريخنا العربي. ومصطلح “البئر العتيقة” يمكن تحمليه عدة دلالات تثري الرواية، منها حسب- فهمي المتواضع- إنها مسار تاريخي أسود في حياة الأمة العربية.
“الصامت” رواية ثرية تُقرأ من عدة زوايا، لما فيها من ترابط الواقع بالخيال، وتتسم بالوحدة العضوية وتماسك الزمكان، وبعد قراءتي سرديات شفيق التلولي السابقة أستطيع القول إن مشروع شفيق التلولي الروائي بعد الصامت يختلف عن ما قبلها.