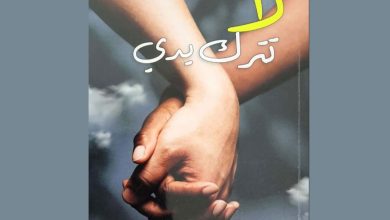مداخلةٌ لديوان ” رهين النكبات ” للشاعر الدكتور أسامة مصاروة “
بقلم: الدكتور حاتم جوعيه - المغار - الجليل -
تاريخ النشر: 01/04/25 | 19:51
عمل الشاعرُ والكاتبُ والروائيُّ والناقدُ الكبير الدكتور أسامة مصاروه من سكانِ مدينةِ الطيبة – المثلث في مجالِ التدريس فترةً طويلة وفي عدَّةِ مدارس وكليات – محليًّا وخارج البلاد – حتى سنِّ التقاعد، ومع ذلك لم تتوقف نشاطاته الأدبية والثقافيَّة وكتاباته الفكرية والإبداعيّة، ويُعَدُّ وبجدارةٍ علما ثقافيًّا بارزا ورُكنا هامًّا من أركانِ الثقافةِ والأدب المحلي. أصدر حتى الآن 37 كتابا في شتَّى المواضيع. يكتبُ الشعر والأدبَ والأبحاثَ والدراسات والمقالات المتنوِّعة في ثلاث لغات: العربية والعبرية والإنجليزية. وقد نقل الى اللغة العربية بعض مسرحيات الشاعر الإنجليزي الشهير وليام شكسبير.
وديوانهُ هذا الذي بين أيدينا يحوي (400 رباعيَّة)، وقد نظم شاعرُنا هذه الرباعيَّات خلالَ فترةٍ قصيرة عندما كان موجودا خارج البلاد، سكبّ فيها لواعجَهُ ومشاعرَهُ الجياشة. وهذه الرباعيَّاتُ مُترَعةٌ بالمشاعر الوطنيةِ والإنسانيةِ وَمُشِعَّةٌ بالمجدِ والإباءِ والاعتزاز بالنفسِ والتفاخر والتغنِّي بالكرامة والمبادئ والمثل السامية، وعميقةٌ بالمعاني الفلسفية. ويذكِّرنا شاعرَنا في هذه الرباعيّاتِ بكبار الشعراء العالميين- عربا وأجانب، مثل: بابلو نيرودا، لوركا، وليام شكسبير وعمر الخيام وناظم حكمت والمتنبي وجبران خليل جبران وغيرهم من العمالقة. ويذكرنا بشكل خاص بعمر الخيام في رباعيَّته، وخاصة في صددِ فلسفتهِ الوجوديَّةِ، ومفادُهَا استغلال كل لحظة من عمرنا ووجودنا على هذه الأرض من أجل السعادةِ والرغد والعيش الهنيء.
بيدَ أنَّ فلسفة الدكتور أسامة مصاروة الوجودية تختلفُ نوعا ما عن فلسفةِ الخيام حيث يشوبُها الطابعُ الوطني والإنساني، وتدعو للعيش الحُرِّ الكريم والشريف، وهذا يتحقَّقُ إذا كان الإنسانُ يعيشُ في وطن مُستقلٍّ ومُحَرَّر غير مُحتلٍّ وغير تابع لأيةِ سلطة خارجية، وينعمُ فيه بالحريةِ ويعيشُ مرفوعَ الهامةِ بشمَمٍ وإباءٍ، لأنَّهُ حسب مفاهيم ومنطلقِ شاعرنا ومفاهيم كلِّ إنسان وطنيٍّ حرٍّ وشريف وأبيٍّ فالسعادة الحقيقية ورغد العيش والهناء لا يتحقَّقُون بدونِ الكرامةِ والعزّةِ والشَّمم والاستقلال التام، أي استقلال الوطن وتحرر النفس والروح والجسد والفكر من التبعية والاستغلال.
ولنرجع إلى رباعيَّاتِ الخيام فقد نظمها الشاعرُ والعالمُ والفيلسوف الفارسي عمر الخيام باللغة الفارسية. والجدير بالذكرِ أن الخيّامَ كان ينظمُ الشعرَ باللغتين: العربية والفارسيَّة، وتُرجمت هذه الرباعيات بعد عدةِ قرون إلى اللغة الإنجليزية، ونالت شهرةً كبيرة وواسعة ً في إنجلترا ودول أوروبا لدرجةٍ أنها كانت تُباعُ في المكتبات أكثر بكثير من أعمال شكسبير الشعرية والمسرحية. وكانت تُعَدُّ في انجلترا وأوروبا شعرًا وأدبا عالميًّا دون جدال وعندما كان العرب لا يعيرونها أيَّ اهتمامٍ. وقد تُرجمت بعد ذلك إلى اللغةِ العربيةِ وإلى لغاتٍ أخرى عديدة نظرا لشهرتها وأهميَّتها. ومن الأدباء والشعراءِ العرب الذين قاموا بترجمتِها إلى العربية (في بداية القرن العشرين) الشاعر المصري الغنائي الكبير أحمد رامي والشاعر العراقي الكبير أحمد صافي النجفي ووديع البستاني ومصطفى وهبي التل ( عرار) ومحمد السباعي وغيرهم. وأحسنُ وأجملُ ترجمتين للرباعيَّات هما: ترجمة أحمد صافي النّجفي وترجمة أحمد رامي، وأما الأخير الذي لشدَّةِ اعجابه برباعيَّات الخيَّام بعد أن قرأها مُترجمةً للإنجليزية اضطرَّ أن يدرسَ اللغة الفارسية عدة سنوات حتى أتقنها جيدا، وقرأ رباعيَّات الخيام بلغة الأم الفارسية وبعدها قام بترجمتِها مباشرةً من الفارسيةِ إلى العربيَّة. وفعل نفس الشيء أيضا أحمد صافي النجفي. ويبدو واضحا أن الدكتور أسامة مصاروة كان قد قرأ الرباعيات بالترجمةِ الإنجليزيةِ وقرأها أيضا ترجمةَ احمد رامي بالعربيَّة، وتأثر بترجمةِ رامي كثيرا ولهذا التزم مثلهُ أيضًا بوزن واحدٍ فقط في نطم رباعياته، وهو بحر(السريع). ولم يستعملْ أوزان أخرى في نفس القصيدة الطويلة (الرباعيَّات) كما فعل الشاعرُ أحمد صافي النجفي والشاعر أحمد رامي التزم بجواز واحد فقط في نهايِة كل شطرةٍ (فاعِلُنْ) وعروض هذا الوزن هو: (مستفعلُنْ مستفعلُن فاعِلُن) وبالإمكان أن نضعَ في نهايةِ كلِّ شطرةٍ في الصدر والعجز بدل (فاعِلُن) (فَعْلُنْ) أو (فَعِلُن). وشاعرنا استعمل، بدورهِ، التفعيلتين أو الجوازين فأحيانا فاعِلُن وفي بعض الأحيان فعِلن على عكس أحمد رامي الذي التزمَ بجواز فاعِلُنْ فقط. ورباعياتُ الدكتور أسامة مصاروه تختلفُ عن رباعيَّاتِ الخيام حيث يتطرقُ فيها إلى مواضع عديدةٍ وَمُتشعّبةٍ لم يتطرقْ إليها الخيامُ عدا الفلسفة الوجوديّة ولغز الكون وسر الحياة والوجود واغتنام كل الفرص من أجل متعة ِالحياة والسعادة الحِسيَّة والجسديَّة والنفسيَّة.
إنَّ رباعياتِ الدكتور أسامة مصاروة متينةُ السبكِ وجزلةُ الألفاظ وقويَّة من الناحيةِ اللغويةِ والبناء الخارجي ومتسلسلةٌ ومُنسابةٌ ومُتناغمة بجماليةٍ مميزة في مواضيعها وصورها وتموجاتها، وعميقةٌ بمعانيها وفحواها واهدافِهَا السامية، وفيها يتجلى البعدُ الوطني والإنساني – كما ذكرَ أعلاه – بالإضافةِ للبُعد الفلسفي. ونجدُ في هذه القصيدةِ أو الملحمة الشعرية التي تُسمَى (الرباعيات) خلاصة تجارب وإبداعات الشعراءِ العظام الذين أثرُوا التاريخَ البشري بروائعِهِم الأدبيةِ الخالدةِ التي كانت منارًا ونبراسا وغذاءً روحيًّا وفكريًّا للبشريَّةِ على مرِّ العصور. ونجدُ ونلمسُ في هذه الرباعيّات روح َ وشخصيَّة عمر الخيّام وآراءَه وفلسفته في الحياة وقدرته الفنية الفذة في رباعيّاته، ونلمسُ أيضا ونستشفُّ وليام شكسبير وبابلو نيرودا وخاصة في أشعارهِ وروائعه الوطنيّة والإنسانية ولوركا وناظم حكمت. ونستشفُّ ونلتمسُ أيضا فلسفة جبران ورومانسيّته الساحرة. ونجد في نفس الوقت عظمة المتنبي وعبقريته وافتخارهِ واعتزازه بنفسه. والذي لفتَ انتباهي كثيرا في رباعيّات الدكتور أسامة مصاروه هو اعتزازه بنفسه والتغنِّي بالكرامةِ والإباءِ والمبادئ الوطنيةِ وتمسكه بها، وحبِّهِ وعشقهِ الكبير لأرضه وبلادة وهذا الجانب وهذا الموضوع أصبح اليوم يضمحلُّ بشكلٍ تدريجي في الشعرِ والأدب المحلِّي، لأن معظمَ الكتاب والأدباء المحليين هم بعيدون كل البعد عن الشعر والأدب الحقيقي الهادف الذي يحملُ رسالة سامية سواء كانت إنسانيّةً أو وطنيّة أو غيرها، وهم في نظري ليسوا شعراء وقد مشوا في مستنقع التطبيع والإذلال وباعوا كلَّ شيءٍ من أجلِ مكاسبهم المادية الآنيَّة. وأما شاعرنا وأديبنا الكبير أسامة مصاروة فلم ولن يرضخ لأحدٍ ولم يسرْ في مستنقع التطبيع وَيَحنِ رأسَهُ كباقي القطيع ولهذا فهو حتى الآن لم يُقدِّمْ لجائزة التفرغ السلطويّة التي يتهافتُ عليها معظمُ الكتاب المحليين وبإذلال مشين. وحسب رأيي ان أهمَّ شيء وميزةٍ في كلِّ كاتب وشاعر هو أن يكون ملتزما وطنيًّا وإنسانيًّا وعقائديَّا والذي يفتقرُ إلى هذه الاشياء فكيف سيكون عنده إبداعٌ وأعمالٌ أدبية وفنيَّة راقية. ولماذا هو يكتب ومن أجل من؟؟!! ولهذا فإن قسما كبيرا من الأدب المحلي (شعرا ونثرا) في الفترةِ الاخيرة هو دون المستوى المطلوب لأنهُ يفتقرُ إلى المصداقيَّةِ والامانة والموضوعيّةِ وللصدقٍ وللروح والنفس النقيَّة الصافية والضمير الحُرِّ والمشاعر الوطنيَّة الجياشة والمرهفة. فكلُّ عمل أدبي لا يوجدُ فيه شعورٌ وإحساسٌ ولواعجُ ذاتيَّة وصدقٌ، ويعالجُ قضايا وأمور عديدة وهامة ليس شعرا ولا أدبا. ولهذا فأنا ومعي يُشاركني الرأيَ كلُّ ناقدٍ وأديبٍ ومثقف ووطنيٍّ وحرٍّ وشريف يعرفُ ماهيَّة وحقيقة الشعر والأدب الحقيقي سنضعُ على قسم كبير من الشعر والأدب المحلي علامة (ْإكس) على هذا الأدب الهابط الذي ليس أدبا، وعلى النويْقدين المأجورين الذين لا يفهمون شيئا في النقد الأدبي والفني، ويحاولون أن يجعلوا من أولئك الطفيليين والمنافقين الدخيلين على دوحةِ الادب والشعر شعراءً وكتابا مبدعين لان ما يكتبونهُ ويخربشونه يفتقرُ إلى جميع العناصر الهامة التي تُحَدِّدُ فحوى وهويَّة َالإبداع والتميُّز. وعدا هذا فإن معظمَ الشعرِ المحلي غيرُ موزون وركيك لغويا وصياغته ومعانيه ضحلة والألوان والأنواع الأدبية الأخرى نفس الشيء أيضا. أما شاعرنا القدير والمبدع الدكتور إسامة ففي كتاباتهِ جميعا الشعرية والنثريّة تكتملُ كلُّ عناصر وأسس الإبداع وفي جميع أشعاره تكتملُ المعادلة الكيميائية بكلِّ مُقومَّاتها والعناصر الضروريّة لتفاعلها. فكتاباتهُ الإبداعيةُ معادلة كيميائيَّة كاملة ولوحةٌ فنيَّة رائعة مشعةٌ بالسحر بالجمالِ والعذوبة تختالٌ في تموجاتِها الخلابة وبالمستوى الفني الراقي.
والجديرُ بالذكر أنَّ قصيدة الدكتور أسامة مصاروه هذه “رهين النكبات” مترعةٌ ومفعمةٌ بالطابع والنفس الملحمي، وقد أطلقَ عليها البعضُ “ملحمة أسامة مصاروة”، وأسلوب هذه القصيدة هو أسلوب الملاحم الشعريّة تقريبا، وتحوي معظمَ الأسس والشروط لكي يُطلقَ عليها اسم (ملحمة شعرية). فالملاحمُ الشعرية يجبُ أن تكون طويلة من ناحية المسافة وتتحدثَ عن فترةٍ ومرحلةٍ تاريخيَّةٍ معينة. وقصيدةُ أسامة مصاروة هذه فيها هذه العناصر والأشياء. والملاحم الشعرية أيضا تُكتبُ وتصاغ بأسلوب سردي، وقد نسج ونظم الدكتورُ أسامة قصيدته المطولة هذه بأسلوبٍ سردي، ولكن معظم الملاحم الشعرية تتحدَّثُ عن الحروب والمعارك، وعلى الأقل يكونُ فيها وصفٌ مُطوَّلٌ لمعركةٍ معينة. وَيُدخلُ شعراءُ الملاحم في قصائدهم دائما شخصياتٍ وأبطالا قد يكونُ البعضُ منها حقيقيًّا والبعض أسطوريًّا. ويكونُ هنالك حوارٌ أيضا (ديالوج) بين الشخصيات وأبطال الملحمة الشعرية. وأما قصيدة الدكتور أسامة مصاروة الطويلة فلا يوجدُ فيها ذكرٌ ووصفٌ لأيةِ معركة حربية ولا وصف لصليل السيوف وصهيل الخيول وصراخ الأبطال وانتشار الغبار إلى عنان السماء، ونحنُ عندما نقرأ وصفا لمعركة في بعض الملاحم الشعرية نحسُّ ونشعر كأنَّ المعركة تجري وتحدثُ أمامنا ونراها بأمِّ أعينِنا وكأننا نسمع صليل السيوف وصهيل الخيول وصراخ الفرسان ونرى ارتفاع وتفاقم الغبار الذي يحجبُ الرؤية. ولم يدخل الدكتور أسامة شخصيات وأبطالا لملحته سوى شخصية والده بشكل مباشر وذكر شخصية الخليفة المعتصم والقعقاع بشكل سريع وهامشيّ.
يتحدثٌ الدكتور أسامة في قصيدتهِ المطولة عن مرحلةٍ تاريخية معينة مثل جميع القصائد الملحميّة، وموضوع القصيدة بشكل عام هو عن القضية الفلسطينيَّة، ولكنه لم يتحدثْ عن هذا الموضوع بشكل مباشر وواضح في بدايةِ القصيدة والصفحات الأولى منها بل بشكل رمزي. واستعملَ التوظيفَ الدلالي في هذه القصيدة ليصل إلى ما يريده ُبشكلٍ تقنيٍّ فنّيٍّ ذكيٍّ. فقد وظفَ شخصيّة طائر (الواق واق) الذي يرمزُ إلى المحتلِّ الذي يسطو على أوطان وأراضي غيره ويرتكبُ مجازر فضيعة بحق السكان المدنيين ويقتلُ ويفتكُ ويغتصبُ ويهجر سكانها الأصليين. والمعروف عن طائر الوقواق أنه طائر عدائيٌّ ويشكلُ دائما خطرا على الطيور الضعيفةِ والمسالمة. وعنده عادة موروثة وهي غريزة فطرية حيث يسطو على أعشاش غيره من الطيور ويحتلها ويقيم فيها ويقتل الأفراخ الموجودة فيها ويأكلها.
ويرمزُ الشاعرُ إلى طائرِ الحمام وعشِّهِ للوطن الجميل وللإنسان أو الشعب الذي كان ينعمُ بالهدوء والسكينِة والأمنِ والسلام، للشعب الوادع البريء قبل أن يأتي المحتلُّ ويقتلعهُ من بلادهِ ويقتلَ أطفالهُ. وهذا ما جرى بالضبط للشعب الفلسطيني عام 1948 (عام النكبة) وفي النكبات المتتالية في ما بعد وما جرى في غزة مؤخرا وهي محاولة لتطهير عرقي. وكان هنالك الكثير من حروب الإبادة والتطهير العرقي في حقِّ شعوبٍ عديدة على مرِّ التاريخ ومنذ الوجود.
هذا وقد استعمل الدكتورُ أسامة مصاروة أيضا في مطولته الأسلوب التهكمي الساخر الذي يفتقرُ إليه معظمُ الأدب العربي محليا وخارج البلاد. ولقد وظفَ شخصية الحمار الذي يرمزُ إلى الإنسان البسيط والساذج والبريء وغير المتعلم، وأنه بشكل تلقائي وبحسٍّ فطريٍّ يدركُ ويعي ما يجري حوله من أمور وما سيحدثُ قريبا من أحداث جسام، وعنده بعد النظر والتحليل الصحيح للخارطة السياسيّة محليًّا وعالميًّا. وعندهُ كرامة وعنده إحساس وشعور وعزَّة نفس أكثر بكثير من حكام العرب الخونة الذين سلموا رقابهم لجلاديهم وربطوا مصيرهم ومصير بلادهم وشعوبهم بالأجانب الطامعين أعداء شعوبهم.
في قصيدة أسامة مصاروة يتجلى بوضوح البُعدُ الوطني الذي يشوبهُ الطابعُ والحِسُّ الإنسانيُ والأمميُّ. ووطنيةُ الدكتور أسامة لا يوجد فيها تطرفٌ أو حقدٌ وضغينةٌ على أيّ شعبٍ آخر، فهو يُحبُّ شعبَه ويحبُّ أيضا ويحترمُ جميعَ الشعوب الاخرى. فالإنسانُ هو أخُ الإنسان، ويدين، بدورِهِ الشرَّ والعدوانَ دائما، ويُندِّدُ فقط بالمجرمين والقتلة والسفاحين الذين هم في كلِّ مكان وبقعة على هذه الأرض ينشرون الفسادَ والدمار، الذين يحتلون بلاد غيرهم ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ، ويفتكون بالناس الأبرياء والعزل. ويتمنى وينشدُ، بدورهِ، الخيرَ والأمنَ والسلام والاستقرار والعيش الهانئ الرغيد لشعبه ولجميع شعوب الارض. إنَّ المحبة الإنسانية الخالصة والرُّؤيا الفلسفيَّة المُثلى والأمميّة توصلان كلِّ عملٍ أدبي أو فني راقٍ إلى العالميّة، ولا يكونُ مُتقوقِعًا في حَيِّز وأفقٍ ضيِّقٍ وفكر ومفهوم ضحلٍ. ولهذا أقول بدون مبالغة إذا تُرجمت هذه القصيدة ترجمة دقيقة وفنيَّة إلى لغات أجنبيّة سنحقَّق شهرة عالمية وستضاهي قصائد ومطولات الشعراء العالميين الخالدة.
وأريدُ ان أضيفَ أن هنالك عدة شعراءٍ محليِّين كتبوا قصائَدَ الرباعيَّات وحاولوا تقليدَ الشاعرَ والعالمَ والفيلسوفَ عمر الخيام في رباعيّاتِهِ ولكنهم أخفقوا، فأين الثريا من الثرى. لقد كانت كتاباتهم دون المستوى المطلوب، فجاءت ضعيفةً ومفككة من ناحيةِ البناءِ والنسيج والسبك، وتفتقر إلى الجزالة والقُوَّةِ لغويا وشكلا وبناء، وتفتقرُ إلى عذوبة الألفاظ وجماليَّتها ووقعها الأخاذ في المتلقي، وَهي مُمحِلةٌ رومانسيا، ولا يوجد فيها أيةُ صور شعريّةٍ جميلةٍ ولا استعارات وابتكارات بلاغيّة جديدة، ومستواها الفنِّي منخفض ومواضيعها ومعانيها سطحيةٌ وسخيفةٌ أحيانا ولا يوجدُ فيها أيُّ نوع وشيءٍ من الإبداع والتجديِدِ والفنِّ والجمال.
أما قصيدةُ الدكتور أسامة مصاروة التي نحن في صددها فتختلفُ كليا. إِنّها أولُ قصيدةٍ رباعيَّة لشاعر محليٍّ في هذا المستوى العالي والراقي، وفيها كلُّ مقوماتِ وأسسِ الإبداع والجمالِ والروعةِ، وَمُشِعَّة بالأجواء الرومانسيّة والمعاني الفلسفية، ومع إنها كُتِبَتْ بروح ونفس ملحميٍّ فهي تتميَّزُ عن الملاحم الشعريّة بعذوبةِ ألفاظها وبصورها وبلوحاتِها الجميلةِ الخلابة وبأبعادها الرومانسية ِالحالمة وشطحاتِها الصوفيَّةِ ومواضيعها ومعانيها العميقةِ وبأهدافها الساميةِ: فنيًّا وبلاغيا وإنسانيا واجتماعيا وسياسيًّا ووطنيا وتجديدا وابتكارا وإبداعا. ولا يوجُد فيها قعقعةٌ وصليلٌ وصهيلٌ وصخبٌ وضجيجٌ وزئيرٌ ونفيرٌ وكرٌّ وفرٌّ كالملاحم الشعريَّةِ المعروفةِ التي يحتلُّ فيها الجانبُ العسكري حيِّزا كبيرا، وفيها ذكرٌ ووصفٌ مُسهب للمعارك والحروب الطاحنة – التاريخيَّة والأسطوريَّة.
في القصيدةُ أيضا الطابعُ الرّوائي، وتجدرُ الإشارةُ إلى أن الدكتور أسامة مصاروه ناقدٌ وروائي أيضا وله العديد من الروايات المطبوعة. وهذه القصيدة هي روايةٌ كتبتْ بأسلوب شعري (أبيات مع وزن وقافية) وبأسلوب سردي مُسهب، ولكن لا يوجدُ فيها شخصياتٌ وأبطال وحوار مستمر(ديالوج) مع أبطال الروايةِ أو القصيدة. وفي بدايةِ القصيدة يتحدثُ الشاعرُ عن الوطنِ بشكلٍ شبهِ رمزيٍّ ويشبِّهُهُ ويصفهُ بالبيت. والقارئ يخالُ لأول وهلةٍ أنَّ الحديثَ هو عن بيتٍ جميل وادع وليس عن وطن وأرض تحتل ويُهَجَّرُ سكانُها عنوةً. ويتحدثُ الشاعرُ أيضا في عدة رباعيات وبشكل سرديٍّ وعلى لسان الأب والابنِ عن الحياة الجميلة الوادعة التي كانت في هذه البلاد الخلابة، وأجواء المحبة والألفة التي كانت سائدةً بين السكان، وكيف أنه لا توجدُ عائليَّةٌ وطائفيةٌ ولا حقٌد وضغينةٌ بين الناسِ. كان هذا قبل أن تُحتلَّ البلادُ من قبل الأجانب الغرباء، فيقول الشاعر:
( كانَ لنا في ذلكَ الزَّمَنْ
بيتٌ سعيدٌ دونما مِحَنْ
كانَ مُسالِمًا وَسُكّانُهُ
يحيون في أمنٍ بلا فِتَنْ )
( بيتٌ مُقدسةٌ مَرابعهُ
حتى تطهَّرَتْ منابعُهُ
بيتٌ غدا بينَ الانامِ رُؤًى
لمَّا توَهَّجَتْ شرائعُه ).
وفي صددِ الاعتزاز بالنفس والتغنّي بالمُثلِ والإباء يقول في (رباعيَة رقم 12):
(وَكُنتُ كالنّسْرِ أحِبُّ الذرى
لا عيشَ لي في ظلماتٍ الوَرى
فليسمعِ الطاغوتُ مهما طغَى
ولم أجدْ من باجتِهادي ازدرَى)
ويقولُ بنبرةٍ كلّها تفاؤل وقوَّة عن الوضع العربي الذي لا يُبشِّرُ بالخير:
(وحدتنا وَصفُّنا واحِدُ
والكلُّ للرَّبِّ فقط ساجِدُ
نعملُ جاهدينَ في أرضِنا
ما بيننا أو حولنا حاقِدُ)
ويتحدَّثُ بتوسع عن أجواءِ المحبةِ التي كانت سائدةً في المجتمع الفلسطيني المسالم، والتعاون المشترك بين الجميع، وعدم وجودِ الطائفيَّةِ والعائليَّة. وقد كان هذا قبل عقود. فيقول في هذه الأبيات:
(العيشُ ضنكٌ إنَّما سائرُ
والكلُّ بالكلِّ كذا شاعرُ
لم نعرفِ الحقدَ هناكَ ولمْ
يكُن لدينا خائِنٌ غادِرُ
لا طائفيَّة عرفنا ولا
أيَّ شعورٍ بالعَداءِ علا
وبيننا سَمَتْ علاقاتُنا
لا واحدَ منَّا طغى أو قلى
واسمِ الحمولةِ التي ننتمي
لها وربَّما بها نحتمِي
ما كان ذا معنى لأجيالِنا
حتى بأحضانِ العِدى نرتمِي)
وينتقلُ الشاعرُ بعد ذلك في الحديثِ إلى المحتلِّ، ويرمزُ للمحتلِّ بطير (الواق واق) الذي جاء بشكل مفاجئٍ ٍوغامضٍ، ولم تكن معروفةً هويتهُ ومآربه وأهدافهُ في البداية. وبعد فترة قصيرة بدأ يتبعهُ الكثيرُ من طيور الواق واق، فنشروا الفسادَ في الأرض وقتلوا وفتكوا بالطيور الضعيفة والمسالمة. وبعد ذلك يبدأ شاعرُنا في الحديثِ عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكلٍ شبهِ مباشر ومفهوم للجميع وبانسيابٍ وتسلسل سريع. ويتحدثُ بشكلٍ موسع ومُسهبٍ عن حكام العرب والأنظمة ِالعربية العميلة التي تآمرتْ على شعوبها وبلادِها. فيقول مثلا:
في رباعيَّات (172 – 173):
(قيلَ اسمهُ الوقواقُ لا أعرفُ
وَعندهُ يا ويلتي شَغفُ
بالقتلِ والتَّدميرِ لا يَرْعَوِي
ولن تراهُ حيثما يزحفُ
لعلّهُ علّمَ إبليسَ ما
أتقنَ من مُكرٍ ومَنْ عُلّما
مَن قتنٍ فرَّقتْ جمعَنا
ولم تزلْ تزيدُنا مأتما ) .
ويقول في رباعيات (175 – 157):
وعندما جاءِتْ أفاعي العِدَى
وأوقعَتْ بنا سُمومَ الرَّدَى
وَجدتُ نفسي مع أهالي القُرى
في غربةٍ غطّتْ نواحي المدى
قالوا لأسبوع سنبقى هُنا
إذ ما لنا عن أيِّ بيتٍ غنا
مع أنَّ حالَ الأهلِ يُرثى لها
قيلَ اصبرُوا فعودنا قد دنا
ومرَّتِ العقودُ تترى بنا
ولا يرى الوضعَ سوى ربِّنا
إخوتُنا من زمنٍ نسَوا
وجودَنا من شرقِنا لغربِنا
ويقولُ:
أليسَ ما يجري لنا كافيا
لقد غدا الصخرُ هنا داميا
لكنّكم إخوتنا نُوَّمٌ
وليسَ منكم ويلتي واعِيا
المعنى هنا واضحٌ جدًّا. يتحدَّثُ الشاعرُ عن عام النكبة (عام 1948) وعن الفلسطينيِّين الذين هُجِّرُوا من قراهم ومدنهم بالقوَّةِ وهم تحت القصف، وقد لجؤُوا إلى الدولِ العربيةِ كلبنان وسوريا وشرق الأردن، وكانوا يتوقعون كما قيل لهم: إنَّ إقامَتهم في الغربة مؤقتة لأسبوعين أو ثلاثة، ولكن مرَّتْ عقود ٌمن الزمن وما زالوا نازحين يعيشون خارج الوطن.
ويُخاطبُ الشاعرُ حكامَ العرب الذين خانوا شعوبهم وخدموا الأجانب:
(فكيفَ تدعمُونهُ ويلكم ْ
أليسَ أهلُنا همُ أهلكمْ
هلْ فرَّغوكم من عروبتكمْ
حتى فقدتُم ويلكم أصلكمْ ).
وفي رباعيَّة رقم (184) يتحدثُ بشكلٍ تهكميٍّ ساخر في هذا الزمن الجائرِ والفاجرِ عن الأنظمةِ العربيةِ العميلة والذي يجعل من الإنسانِ النظيفِ يتنازل عن مبادئهِ ويصبحُ تابعا وعميلا لهذه الأنظمة الجائرة والظالمة:
وهكذا يا عالمَ الظُّلَمِ
وعالم القسوةِ والألمِ
وفي زمانٍ عفنٍ نتنٍ
أصبحتُ من عمالةِ النظُمِ
رهينَ غُربتيْنِ دونَ الْورى
كَأَنَّما قُبِرْتُ فوقَ الثَّرى
بيْتي هُناكَ إنّما الْغاصِبُ
بالْقصْفِ والتَّدميرِ بيْتي ذَرى
وفي رباعيّة رقم (182) يتحدثُ الدكتورُ أسامة مصاروة بكلِّ وضوح وصراحةٍ عن دورِ المحتلِّ وسياستِهِ وأهدافه:
(نحنُ بنو المَنونِ ذا فكرهُمْ
ذا سرِّهُم بل إنَّهُ أمرُهُمْ
لقتلِنا وسلبِنا أرضِنا
صراحةً هذا فقط دورُهمْ)
وفي رباعية (188) يُوَضِّحُ خطرَ المحتلِّ على شعبه فيقول:
(يا إخوتي احذروا النتِنا
وحشًا قبيحًا حاقدًا عفنا
دماؤُنا يمتصُّهَا شهوةً
حتى يُصَفِّي الأرضَ والوطنا)
وفي الرّباعيَّةِ رقم 194 يتحدثُ بمرارةٍ عن الوضع العربي المخزي وعن الصمتِ العربي الطويل واللامبالاة من قبل الحكام العرب والأنظمة العربية التي لا تهتمُّ لما يجري من أحداثٍ جسامٍ – محليا وشرق أوسطيا، ولا تهبُّ لنصرةِ الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادةٍ وتطهير عرقي فيقول الشاعر:
(أمرٌ مُحالٌ فهمُهُ عربُ
يرون ما يجري ولا غضبُ
يا ناسُ للذلَّةِ حدٌّ ولا
يُعقلُ هذا الذلُّ ما السَّببُ )
ويقولُ أيضا:
(قد أصبحتْ هامدةً تجثُمُ
في غيهبٍ نهارُهُ مُظلِمُ
من أجلِ ماذا ترقدُ
من أجلِ نذلٍ خائنٍ يحكمُ) .
يظهرُ بوضوح الأسلوبُ التهكمي الساخر في هذه الرباعيَّة.
ويقولُ في رباعيّة رقم (246):
(يا قومَ نفطٍ أذكروا قبلكم
قومَ ثمودَ والقرى ويلكمْ
وَقومَ عادٍ مثلكم اذكروا
حتى وإن طال الزمانُ لكمْ ) .
ويعني الشاعرُ بقومِ نفط حكامَ وزعماءَ العرب وأمراء النفط الأغنياء الذين يعيشون في رفاهية ورغد وبذخ أسطوري ولا ينظرون إلى شعوبهم ومصيرها ومستقبلها، فيخاطبُهم مباشرة ويذكرهم بأقوام عادٍ وثمودَ الذين تجبَّرُوا وطغوا ونشروا فسادًا وظلما في الأرض فأبادهم اللهُ ومحاهم عن بكرة أبيهم، وأنه مهما طال الزمانُ وامتدَّ بحياتهم المترفةِ حياة اللهو الفجور، أولئك الذين لا يعرفون العدالة والرحمة والإنسانيَّة فسيكون مصيرُهم مثلَ أولئك الأقوام والقبائل التي أبادها الله. ولقد وردت قصصُ عاد وثمود في القرآن الكريم. وقبل مجيءِ الإسلام ونزول القرآن كانت معروفةً سيرتُهم وما آلَ إليهِ أمرهُم ومصيرُهم ونهايتهم المشؤومة لجميع القبائل العربية في الجاهلية.
وفي رباعيَّةٍ أخرى قبلها (رقم 222) يخاطبُ الشاعرُ زعماءَ العرب بلهجةٍ أشدّ قسوة وينعتُهم بحثالةِ البشر فيقول:
(يا ويلكُمْ حثالةَ البشَرِ
زبالةَ التاريخِ والأعصُرِ
من أجلِ ماذا بعتُمُ عِرضِكُمْ
من أجل مالٍ فاسدٍ قذرِ)
والمعنى واضحٌ جدا هنا، ويقصد الشاعرُ كلَّ زعيم ومسؤولٍ عربيٍّ وكلَّ شخص عربي باع ضميرَهُ وشرفه وخان شعبَه وتآمرَ عليه من أجلِ مكسبٍ مادي آنيِّ حقير.
وفي رباعيات رقم (280 -282) يقول:
(يا مُترفي النفطِ ألا انشغلوا
بعهركم وفسقِكم واعملوا
ثانيةً كلَّ خيانتكمْ
إن يُمْهِل ِالرحمنُ لا يُهمِلُ
عندئذٍ سوفَ نرى نفطكمْ
والمُنتنَ الحامي لكمْ وسطكمْ
إن ينهضِ الثُّوَّارُ لنْ يُنقذنْ
عروشكم حتى ولا رهطكم
إن يُطلِ الرَّحمنُ أعمارَهُمْ
يزِدْ طغاةُ العُرب أوزارَهُمْ
فيكبرُ العقابُ بلْ يعظمُ
ومثلهُ ينالُ أنصارَهمْ)
ويوظفُ الشاعرُ شخصياتٍ تاريخيَّة هامة في رباعيّاته، مثل الخليفة العباسي المُعتصم الذي هَبَّ لنصرة امرأةٍ عجوز من بني هاشم وجهَّزَ جيشا عرمرَمًا لمحاربةِ الروم كان أولهُ في بلاد الروم وآخره في بغداد. ويعملُ الشاعرُ مقارنةً مضحكة بين المعتصمِ والحكام والعرب والمسلمين قديما وبين الحكام والزعماء العرب المتخاذلين اليوم. ويقول في رباعيَّات (289 – 291):
( تاريخُنا يذكرُ مُعتصِمَا
خليفة ما كانَ مُسْتسلِمَا
بل كانَ حُرًّا أبيًّا عادِلا
ولم يكُنْ يا عُربُ مُنهَزِمَا
بلْ هَبَّ للعَجُوزِ مُنتصِرَا
بطردِهِ الرومانَ والقيصَرَا
ما إن أتاهُ الخبرُ المُحزِنُ
حتى الجنودَ للعِدَى سيَّرَا
فأينَ مِنَّا اليومَ مُعتصِمُ
وَوَضعُنا اليومَ تُرَى مُؤلِمُ
مُعتَصِمُو اليومَ عبيدُ العِدَى
تحسِدُ إذلالهُمُ الغنَمُ ) .
وفي الرباعيات التي تليها يخاطبُ الشاعرُ اللهَ جلَّ جلاله بنبرة حُزنٍ وأسًى وألم شديد، ويسألهُ: هل يُرضيه هذا الوضع المُزري والذل الكبير والخنوع الذي تعيشهُ الأمَّةُ العربيةُ اليوم من المحيط للخليج فيقول في رباعية رقم (293):
(يا ربُّ هل تُرضيكَ أوضاعُنا
ألمْ تصِلْ إليكَ أوجاعُنا
بلى لقد سَمِعْتَهَا إنَّمَا
النصرُ متى يرجعُ “قعقاعُنا”)
يذكرُ الشاعرُ في هذه الرباعيّةِ القائدَ والبطلَ الإسلامي الشهير والشجاع “القعقاع بن عمرو التميمي”، وأن النصر للعروبةِ على الأعداء وعلوَّ شأنهم ومكانتهم في العالم وبين الشعوب لا يتحقق إلا إذا تغيَّرت القادةُ والزعاماتُ العربية وحلّت مكانها قياداتٌ أخرى جديدة شجاعةٌ وأبيةٌ، عندها عزة النفس والإباء والإيمان والغيرة على الدين والعرض والشرف والأرض والوطن مثل القعقاع بن عمرو التميمي أو خالد بن الوليد. وكان القعقاع ُ يُعَدُّ بألف فارس وفيه يُضربُ المثلُ الشهير: (لا يُهزمُ جيشٌ فيهِ القعقاع).
ويتجلى الشعورُ الوطنيُّ الجَيَّاشُ في رباعيَّة رقم (295):
(أنا الكريمُ الحُرُّ والصَّادقُ
أنا الذي للوطنِ العاشقُ
أقضي الحياةَ تائِهًا ضائِعًا
في حينِ من يحكُمُنِي مارِقُ)
وفي هذه الرباعية يُجسِّدُ الدكتورُ أسامة مصاروة مشاعرَ وأحاسيسَ ولواعجَ كلَّ إنسان وطنيٍّ حُرٍّ وشريف في كل مكان في هذا العالم، وليس فقط الإنسان الفلسطيني والعربي. وستبقى هذه الرباعيَّةُ أنشودةً ولسانَ حالِ كلِّ من يريد أن يعيشَ بكرامةٍ واعتزاز وشمم وشموخ في وطنهِ وعلى تراب آبائهِ وأجداده، وأن يكون وطنهُ مستقلا ومعزَّزا وليس مُحتلا من قبلِ الغرباء، وتعكس هذه الرباعيةُ بالضبط شاعرَنا القدير الدكتور أسامة وأيديلوجيته ومنطلقهُ الفكري والإنساني.
ويقول أيضا:
(فكلُّ ما يقولُهُ كذبُ
وكلُّ ما يفعلُهُ يُشجَبُ
وَيَدَّعي الإسلامَ دينا لهُ
والقلبُ واهٍ فارِغٌ خرِبُ)
ويقصدُ هنا كلَّ زعيم ومسؤولٍ عربيٍّ لا يصدقُ في كلامه ولا يفي ولا يلتزم بوعودِهِ، ويتبجح بالوطنيّةِ زيفا وبالإيمان والتقوى بهتانًا وهو بعيد كليًّا عن تعاليم الإسلام وجوهر الدين الحنيف، وفي نفس الوقت يخونُ بلادَهُ وَيتآمرُ على شعبهِ وأمَّتهِ والإسلامَ والعروبة منه براءٌ إلى يوم الدين.
وفي رباعيات رقم (201– 302) يصلُ الشاعر إلى قمةِ السخريةِ والتهكم حيث يوظف شخصية الحمار الّذي لديه الإحساس بالإباءٍ والعِزّةِ والكرامة ما لدى جميع الزعماء العرب مجتمعين. فهو وإن كان حمارًا يرفض ذّلَّ وهوانَ وخنوع وخضوع الزعماءُ العرب حتى غدوْا عبيدًا للغرب والأجانب فيقول:
(إن يلبسِ الحمارُ ما نلبسُ
أو يضعِ التاجَ ألا يرفسُ؟
إن يحملِ الأسفارَ قاطبةً
هل بينَ كُتَّابٍ لنا يجلسُ
كيفَ وهذا الجحشُ لا يملكُ
كرامةً حتى بها يُدرِكُ
غريزةُ الجحشِ التي يُشبعُ
لسوفَ بالجحشِ غدًا تفتِكُ) .
وفي رباعيات رقم (304-305) يذكر الشاعرُ مرةً أخرى النفط العربي الخليجي وأن هذا النفط في يوم ما سوف ينضبُ ويجفُّ، وربما بعد عقود أو قرون وسيرجع سكانُ بلاد النفط وحكامها إلى حياةِ البداوة البدائيةِ وإلى الجِمال والحمير كما كانوا سابقا قبل حوالي مائة سنة (قبل اكتشاف النفط):
(والنَّفطُ لن يظلَّ للأبَدِ
لسوفَ يختفي كما الزَّبَدِ
والناسُ أصلا لا وُجودَ لهمْ
إلّا كما العبيد في البلدِ
أيُّ مصير أيُّ مُستقبلِ
لشعبِكمْ في زمنٍ مُقبِلِ
بلا مشاريعَ ولا دولةٍ
فالحُكمُ كلُّ الحكمُ للهيكلِ)
وفي رباعية رقم (315) يتحدثُ الشاعرُ عن مشيئةِ الربِّ وحكمتهِ التي لا يُدركُ كنها ومفادَها إلى الآن العقلُ البشري المحدود، ويعجزُ أمام عظمةِ الخالق وقدرتهِ الأزليةِ الأبديَّة. في هذه الرباعية نجدُ معنى وبُعدا فلسفيًّا ويُعيدُ الدكتور اسامة مصاروة إلى أذهاننا الفيلسوف والعالم الشاعر عمر الخيام في رباعياتهِ التي تنضحُ وتشعُّ بالأسئلة الفلسفية، وخاصة في فلسفته الوجوديَّة. فيقول الدكتور أسامه:
(قالوا بأنَّ الرَّبَّ قد يُنعِمُ
على أناس ثمّ ينتقِمُ
كم طرُق للربِّ كمْ سُبُلٍ
نجهلُ كُنهَهَا ولا نفهَمُ ) .
وقد نجدُ التفاوُتَ الطفيفَ، في بعض الرباعيات، في هذه القصيدة المُطولة من ناحية الأبعاد الفنيَّةِ والجماليَّة والشكليَّة. ففي بعض الرباعيَّاتِ يهتمُّ
الشاعرُ بالموضوع والمعنى أكثر من البناء والمظهر الخارج والشكلي للأبيات والألفاظ الجميلة المُمَوسقة وكأنَّ عشرات الرباعيات المتتاليةِ في هذه المطولة نظمَها على نفس واحد دونما توقف وتريُّثٍ والتفاتٍ للخلفِ، ودون انتباه لجماليةِ الألفاظِ وعذوبتِها ووقعها الجميل والأخّاذ على المتلقي، ساكبا فيها عصارةَ فكرة ومشاعره وصَابًّا جامَ حنقهِ وغضَبهِ على الواقع المرير وعلى الحكام الأنذال أعداء شعبه. وهنالك أيضا الكثيرُ من الأبيات يتكاملُ ويتألقُ فيها الإبداعُ والجمالُ من ناحية المعاني العميقة والصور الشعريةِ الخلابة والاستعارات البلاغيّة المبتكرة والجزالة، واللغة الشعرية الساحرة والمستوى الفني الراقي (أي الإبداع الظاهري والباطني والجوهر والمظهر).
وفي الأبياتِ الأخيرة من قصيدة الرباعيَّات يظهرُ عنصرُ الإيمان بوضوح وجهارة، وأن الربَّ قادرٌ على كلِّ شيءٍ، ويستطيعُ أن ينقذ كلَّ شعبٍ مظلوم ومضطهدِ من جلاديه ومغتصبي حقوقه وَمُحْتلِّي بلاده. حتى لو أنَّ كلَّ العالم العدواني السُّفلي ودول الاستعمار جميعَها وكل قوى الشرِّ وشياطين الأرض والكفرة وقفت ضدَّهُ. ويخاطبُ شاعرُنا المحتلَّ وكلَّ ظالم مُستبدٍّ مُتغطرسٍ يستعمل القوةَ والبطشَ وكلَّ أدواتِ القمعِ والفتكِ ضدّ اَلضعفاء والمساكين وضدَّ الشعوبِ الضعيفةِ التي يحكمُها: إنَّ الربَّ يُمهلُ ولا يُهملُ وقادرٌ على أن ينتقمَ لهم. ولسوف يكونُ مصيرُهُ وألمُهُ (المُحتل) أصعبَ بكثير من الشعوب التي يذلّها وَيُنكّلُ بها ظلما وعدوانا. يقول الشاعرُ في رباعيات رقم (318 – 320):
(جُهَنَّمُ التي تُهَدِّدُنا
بهَا وَحِقدًا تتَوَعَّدُنا
هلْ أنتَ أم رَبُّكَ خالقُهَا
وَمَنْ سِو َى الرَّحمن يُنجِدُنا
إن كُنتَ يا مَسخَ مُؤجِّجَها
وكنتَ لا الربُّ هَيِّجَهَا
إمنَعْ بدايةً حرائقَهَا
في أرضكُمْ إن كُنتَ مُخرِجَهَا)
وأخيرا نُهنِّىُ الشاعرَ والناقدَ والروائيَّ الكبيرَ الدكتور أسامة مصاروه على هذا العملِ والإنجاز الشعريِّ الإبداعيِّ الراقي والمُميَّز الذي ستكونُ لهُ بالتأكيد أصداءٌ كبيرةٌ في عالم الشعرِ والأدب محليًّا وعربيًّا وعالميًّا. وأقولها وبكلِّ صدقٍ وأمانةٍ يحقُّ لهذا العملِ الإبداعيِّ الخالدِ أن يُترجمَ إلى معظم لغاتِ العالم وأن يُكتبَ عنه آلافُ المقالاتِ والدراساتِ النقديَّة.