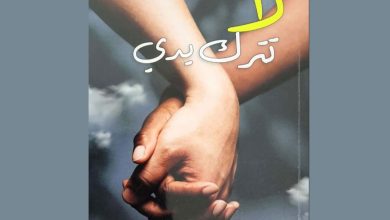عين التينة – رحلة في الذاكرة والهوية بين الحب والوطن
رنا أبو حنا
تاريخ النشر: 02/04/25 | 13:19
قد تكون رواية “عين التينة” للدكتور صافي اسماعيل صافي، الصادرة حديثا عن الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين في رام الله فلسطين.. الرواية الأولى التي أقرأها على شاشة هاتفي النقال بخطوط صغيرة وأضواء خافتة وبجلسة طويلة واحدة.. دون أن أمسك قلما في يدي كي أدون ملاحظات وتعقيبات على بعض الصفحات والفقرات.
دفعني الفضول للبحث عن المؤلف، الدكتور صافي إسماعيل صافي، الذي تكرّم بإرسال النسخة الإلكترونية إليّ، بعد أن تعرفت عليه عبر صفحة الصديق المشترك، الأديب رشيد عبد الرحمن النجّاب، الذي نشر مقالًا لافتًا عن الرواية في صحيفة الاتحاد الأسبوع الماضي. وكما يقول المثل العربي:- “صديق صديقي صديقي”.
تزخر رواية “عين التينة” بالعواطف العميقة التي تجمع بين شخصين تربطهما معرفة طويلة ومشاعر متبادلة: حنان والراوي. يلتقيان أخيرًا وسط مزيج متناقض من السعادة والحزن.. السعادة بلقاء طال انتظاره، والحزن على ما تغيّر فيهما خلال أربعة عقود، ليس فقط في ملامحهما، بل أيضًا في طريقة تواصلهما ومشاعرهما.
رغم إحساس الاغتراب والحنين، تظل نظراتهما مشحونة بالكثير من المعاني، شاهدة على عاطفة لم تخفت وذكريات لا تزال حاضرة. علاقتهما تتجاوز الصداقة التقليدية، لتصبح رابطة غامضة، لا هي حب واضح ولا صداقة خالصة، بل شيء أكثر عمقًا، يجمع الماضي بالحاضر في مشاعر يصعب تصنيفها.
الجدل حول الحب والصداقة
يدور الحوار بينهما حول أغنية “كن صديقي” للشاعرة سعاد الصباح، ليكشف التباين في رؤيتهما للأشياء، حيث يعبر كل منهما عن مشاعره بطريقته الخاصة. التفاعل بينهما هادئ، لكنه مليء بالمعاني المبطنة، بلغة شعرية غنية تتراوح بين الحنين، الندم، الأمل، واليأس، مع حوار ذاتي حول الحب، الصداقة، والوطن.
الرحلة إلى بيسان: بحث عن الذات والوطن
تنطلق الرحلة إلى “بيسان”، لكنها ليست مجرد انتقال جغرافي، بل رحلة نفسية تبحث فيها حنان عن ذاتها التي فقدتها أو ابتعدت عنها. “بيسان” تمثل لها أكثر من مجرد مدينة؛ إنها رمز للهوية المفقودة، أو ربما لإعادة اكتشافها.
تُبدي حنان شوقًا عميقًا وحنينًا جارفًا لبيسان، التي تمثل رمزًا للوطن الضائع والأمل في العودة. ترفض المدن الحديثة، مفضلة الاحتفاظ بذكريات الماضي حيث العلاقة الروحية والتاريخية بين الإنسان ومدينته. فالمكان ليس مجرد جغرافيا، بل هو هوية وذاكرة، وأغنية “خذوني إلى بيسان” لفيروز تضيف طبقة أخرى من الحنين والشجن.
وسط تساؤلات عن معنى البحث عن الذات، تعترف حنان بأن الجمال ليس دائمًا الهدف، بل التجربة ذاتها بما تحمله من ألم أو فرح قد تكون هي الغاية. هذه الفكرة العميقة تتجسد في حوارهما حول الوطن والانتماء، حيث يتأرجحان بين الحنين والواقع القاسي تحت الاحتلال، مع لمحات من الأمل في استعادة شيء من الماضي.
الوطن: بين الحلم والواقع
يطرح النص تساؤلات عن الهوية والانتماء، ويتناول الصراع الداخلي بين التمسك بالوطن والواقع الذي فرضه الاحتلال. يناقش الشخصان معضلة العودة واستعادة الأرض المفقودة، والتغيرات الديموغرافية التي طرأت على القرى. يظهر من الحوار نوعٌ من التقبل الواقعي للمستقبل، رغم الشوق والحنين، فالوطن ليس مجرد مكان جغرافي، بل هو حالة ذهنية وشعورية، تمتد بين الداخل والخارج، بين الحاضر والماضي.
كما يتطرق النص إلى الهوية العربية في ظل الظروف السياسية، مع استدعاء أغنية “وطني حبيبي، وطني الأكبر”، وطرح أسئلة وجودية حول الهوية والعروبة والدين. يعكس الحوار شعورًا بالضياع والتيه، سواء في الداخل أو الخارج، بسبب الاحتلال والتغيرات التي شهدتها البلاد.
الرقص كلغة للروح
في لحظة تتجاوز الكلمات، ترقص “مها” على إيقاع أغنية صوفية: “هي، هي، جايا تصفار وتخضار”، التي تعبر عن مشاعر الاغتراب والخوف من الفقدان. الرقص هنا ليس مجرد حركة، بل لغة روحية تُترجم المشاعر العميقة، حيث تمتزج الطبيعة بالموسيقى، وتفجر مشاعر مختبئة لا يمكن التعبير عنها الا بهذا الرقص العفوي.
“لست أدري”: الاعتراف بالضياع
عندما تعجز الكلمات عن تفسير الحيرة، تحضر قصيدة “الطلاسم” لإيليا أبو ماضي، كتعبير عن الفلسفة الوجودية وحيرة الإنسان أمام الحياة. “لست أدري” تصبح إقرارًا بعدم اليقين، سواء على مستوى العلاقة الشخصية أو العلاقة بالوطن. فالرواية تُسقط العلاقة بين حنان والراوي على العلاقة بالوطن والقضية، متسائلة: هل نعيش في الحلم أم في الحقيقة؟
التاريخ والهوية: بين الذاكرة والنسيان
يبرز النص تعدد الأسماء والعائلات الفلسطينية من خلال اللافتات والمحلات التجارية، ليعكس تنوع الهوية الفلسطينية.. ويعرض الكاتب تأملًا عميقًا في الهوية والانتماء، ويكشف عن الضياع الذي أصاب الفلسطينيين في ظل الاحتلال. يظهر ذلك في مشهد زيارة اليهود المتدينين للينابيع والمواقع المقدسة في فلسطين، والتبارك بها، والاستيلاء على الأرض المحيطة بها، مما يعكس واقع الاحتلال وطمس الهوية الأصلية.
النقاش حول الجغرافيا والحدود
يدور الحوار حول قريتي “الدرباشية” و“عين التينة”، ومسألة انتمائهما الجغرافي والسياسي (هل هما سوريتان أم فلسطينيتان؟). وتتجلى في الحوار عدة مستويات:-
1. الخلاف الجغرافي-السياسي: نقاش حول تبعية القريتين استنادًا إلى مصادر مختلفة.
2. مسألة الهوية والحدود: كيف تشكلت الحدود بفعل الانتدابين البريطاني والفرنسي.
3. الهجرة والاحتلال: نزوح السكان بعد الاحتلال عام 1948.
4. النقد السياسي: التشتت العربي على تفاصيل الانتماء بدل التركيز على القضية الأساسية.
شجرة التين: رمز الصمود
وتبقى شجرة التين بكل تفاصيلها وأنواعها رمزًا للصمود والبقاء سواء كانت الأرض فلسطينية أم سورية، مما يعكس التداخل الثقافي والجغرافي والتاريخي بين الشعبين.
يستخدم الكاتب شجرة التين كرمز لتاريخ طويل ومتشابك، مليء بالصمود والمقاومة ضد محاولات السيطرة والاحتلال. ويبرز التفاصيل الدقيقة حول أنواع التين المختلفة التي تعكس تنوع الحياة الطبيعية والثقافية في المنطقة، وكأنها تمثل كذلك تنوع الهويات والانتماءات.
كما يرتبط النص بالعلاقة بين الأرض والماء، يصف الكاتب كيف يجر الماء معه حبات التين الناضجة، في إشارة إلى استمرار دورة الحياة رغم الاحتلال. كذلك، يعكس الجزء المتعلق بالحدود بين سوريا وفلسطين ومعاناة الشعوب المقسمة بالحدود الاستعمارية، والتي لم تفصل الناس عن ذاكرتهم وأرضهم.
نهاية مفتوحة: تأملات في المصير
يحمل النص نبرة تأملية فلسفية حول الهوية، الزمن، والحب. يتساءل الشخصيات عن معنى الحياة والعلاقات الإنسانية، في دعوة لتقبل الحاضر بتعقيداته. كما يستعرض الاختلاف بين الأجيال في فهم الصراع والذاكرة التاريخية، حيث يختلف من عاشوا الأحداث عن الذين ولدوا بعدها.
وبعد فإن الرواية لا تقدم إجابات نهائية، بل تطرح أسئلة عميقة حول المستقبل، خاصة فيما يتعلق بإمكانية العيش المشترك والتحولات السياسية والاجتماعية.
وبين الحلم والحقيقة، يظل البحث عن الوطن والهوية رحلة لا تنتهي.
(الصورة لشجرة تين في حديقة منزلي في كفرياسيف. تعود أصولها إلى شجرة كانت قد فازت بجائزة “أزكى تين في فلسطين” في المعرض الزراعي عام 1925، مما يجعلها جزءًا من إرث زراعي عريق يحمل في ثماره نكهة التاريخ والذاكرة).
رنا أبو حنا
الناصرة – كفرياسيف
1.4.2025